التاريخ الإسلامي
دون تشويه أو تزوير
التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وحكم الخلفاء الراشدين، مرورًا بالدولة الأموية فالدولة العباسية بما تضمنته من إمارات ودول مثل السلاجقة والغزنوية في وسط آسيا والعراق وفي المغرب الأدارسة والمرابطين ثم الموحدين وأخيرًا في مصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعتبر آخر خلافة إسلامية على امتداد رقعة جغرافية واسعة، وهذه البوابة تعنى بتوثيق التاريخ من مصادره الصحيحة، بمنهجية علمية، وعرضه في صورة معاصرة دون تشويه أو تزوير، وتحليل أحداثه وربطها بالواقع، واستخراج السنن التي تسهم في بناء المستقبل.
ملخص المقال
كان السلطان محمد السادس في السابعة والخمسين من عمره يوم تولَّى حكم الدولة العثمانيَّة، غير أنه لم يكن له أيُّ دورٍ في هذه المرحلة.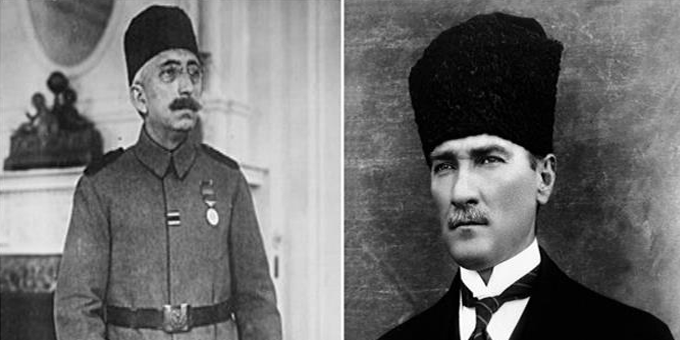
السلطان محمد السادس (1918-1922م)
كان السلطان محمد السادس في السابعة والخمسين من عمره يوم تولَّى حكم الدولة العثمانية[1]. كانت القيادة كلُّها في يد الباشوات الثلاثة؛ أنور باشا، وطلعت باشا، وجمال باشا[2]، وبالتالي لم يكن له أيُّ دورٍ في هذه المرحلة، خاصَّةً أنه تسلَّم الحكم والدولة في حالة حربٍ منذ أربع سنوات، وليس له علمٌ بالأحداث المضطربة التي جرَّتها الحرب على الدولة، ومع ذلك سيكون له دورٌ بعد انتهاء الحرب، وذلك بسبب إقصاء الباشوات الثلاثة بعد الهزيمة.
لم يحكم السلطان محمد السادس سوى أربع سنين، يمكن أن ندرسها تحت العناوين الآتية:
هجوم الربيع الألماني، وردُّ المائة يوم للحلفاء، وهزيمة دول المركز، وانتهاء الحرب (1918م):
كانت معاهدة برست-ليتوڤسك نصرًا كبيرًا لدول المركز، فخروج روسيا من المعادلة جعل الألمان يسحبون أعدادًا كبيرةً من الجنود من الجبهة الشرقيَّة، ويُرسلونها إلى الجبهة الغربيَّة، للقيام بهجمةٍ شديدةٍ على الحلفاء، فيما عُرِف بهجمة الربيع الألمانية Spring Offensive[3]، بدأت هذه الهجمة في 21 مارس 1918م، واستمرَّت أربعة أشهر إلى 17 يوليو 1918م، واستخدمت فيها ألمانيا كامل طاقتها بعد نقل قوَّاتها من جبهة روسيا، ودارت فيها معارك مهولة في شمال فرنسا، وبلچيكا في شكل خمس هجمات متتابعة ضخمة للغاية، حقَّقت القوَّات الألمانيَّة الانتصار في هذه المعارك؛ ولكن بتضحيَّات غير معقولةٍ عسكريًّا، بصورةٍ جعلتها لا تستفيد واقعيًّا بهذا النصر[4].
كانت ألمانيا تريد تحقيق النصر بأيِّ ثمنٍ قبل وصول قوَّات الدعم الأميركيَّة[5]، وهذا دفعها إلى هذه الحملات الجنونيَّة؛ فقدت ألمانيا ما يقرب من سبعمائة ألف مقاتل في هذه الهجمات الربيعيَّة ما بين قتيل، وجريح، وأسير (تحديدًا 688,341 جنديًّا بالضبط)[6]! ترتفع بعض التقديرات عن هذا الرقم؛ حيث تؤكِّد أن القوَّة الألمانيَّة المقاتِلة هبطت من 5.1 ملايين مقاتل قبل هجمة الربيع إلى 4.2 ملايين بعدها؛ ممَّا يعني فقد تسعمائة ألف مقاتل[7]! المشكلة الأكبر أن الجنود المفقودين كانوا من النخبة المدرَّبة التي لا يمكن تعويضها[8]، -أيضًا- لم تكن الانتصارات من الناحية الاستراتيجيَّة ذات قيمةٍ كبيرة[9]، فَقَدَ الحلفاء -أيضًا- أعدادًا رهيبةً من الجنود زادت على ثمانمائة وستين ألف جندي[10]، لكنَّهم لم يترنَّحوا بعد. كان صمودهم على أمل وصول الإمدادات الأميركيَّة.
على الرغم من أن أميركا أعلنت الحرب على ألمانيا في 6 أبريل 1917م فإنها لم تُشارك بشكلٍ قويٍّ إلَّا في صيف 1918م[11]، وذلك كردِّ فعلٍ للهجوم الألماني الشرس في هجمة الربيع. كانت القوَّات الأميركيَّة تصل إلى أوروبا بمعدَّل عشرة آلاف جندي يوميًّا[12]! بدأت قوَّات الحلفاء في 8 أغسطس 1918م في ردِّ الهجمة الألمانيَّة في عمليَّات قويَّة على عدَّة جبهات، وصارت تُحقِّق النصر من يومٍ إلى يوم دون ردٍّ ألمانيٍّ مناسب، وقد استمرَّت هذه العمليَّات إلى 11 نوفمبر -أي ما يقرب من مائة يوم- ولذلك تُعْرَف في التاريخ بهجمة المائة يوم Hundred Days Offensive[13]، وعلى الرغم من الإسهام الأميركي الكبير في النصر فإن الإنجليز كانوا هم العامل الأكبر في هزيمة الألمان، وعمومًا يعدُّ المؤرِّخون المعارك التي تمَّت في هذه المائة يوم هي أفضل انتصارات في تاريخ العسكريَّة الإنجليزيَّة بشكلٍ عام[14]! كانت الخسارة الألمانيَّة -وكذلك خسارة حلفائها- فادحة، وبدأت الانكسارات المؤثِّرة تحدث[15]!
كانت أوَّل دول المركز المنسحبة من القتال هي بلغاريا، التي أعلنت استسلامها في 29 سبتمبر 1918م[16].
صبرت الدولة العثمانية شهرًا أطول، لكنَّها في هذا الشهر فقدت الكثير، ويبدو أن الهزائم الألمانيَّة أضعفت الروح المعنويَّة لكافَّة جنود دول المركز! في أوَّل أكتوبر سقطت دمشق[17]، وفي 7 أكتوبر سقطت بيروت[18]. أدرك العثمانيُّون أن الأمل مفقودٌ في النصر! استقالت حكومة الباشوات الثلاثة في 8 أكتوبر[19] بعد الأداء الكارثي، وبعد الانهيار الذي أصاب الدولة في هذه الحرب التي لم يكن لها داعٍ من الأساس. عيَّن السلطان محمد السادس حكومةً جديدة برئاسة أحمد عزت باشا[20]. بعد أيَّامٍ من استلام الحكومة الجديدة للإدارة أرسلت إلى الأسطول الإنجليزي في بحر إيجة تطلب التفاوض للاستسلام[21]. في هذه الأثناء سقطت حلب في 26 أكتوبر 1918 في أيدي الحلفاء[22]، وهذا مثَّل ضغطًا كبيرًا على العثمانيِّين؛ إذ إن حلب هي آخر حصون العثمانيِّين في الشام. بات الطريق مفتوحًا إلى الأناضول! بدأت الدولة في المفاوضات مع الإنجليز في 27 أكتوبر[23]، ووصلت إلى الاتِّفاق النهائي في 30 أكتوبر حين أعلنت استسلامها الصريح[24]، ووَقَّعت الهدنة الكئيبة المعروفة بهدنة مودروس Armistice of Mudros، ومودروس هو الميناء الذي وُقِّعَت فيه الهدنة على ظهر بارجة بريطانيَّة (في جزيرة ليمنوس ببحر إيجة)[25]. بعد هذا الاستسلام بأربعة أيام -في 3 نوفمبر- استسلمت النمسا أيضًا[26]، وأخيرًا -في 11 نوفمبر 1918- استسلمت ألمانيا[27]؛ لتنتهي بذلك الحرب الطويلة!
هدنة مودروس (1918م):
تمَّت مفاوضات الاستسلام بين حسين رءوف أورباي بك Hüseyin Rauf Orbay وزير الشئون البحرية العثماني، والسير الأدميرال سوميرست كالثورب Somerset Calthorpe قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني[28]. لم تقبل بريطانيا بحضور ممثِّلٍ عن فرنسا معها في الاتفاق[29]، ووافقت الدولة العثمانية كذلك على غياب فرنسا! كان من الواضح أن بريطانيا مهيمنةٌ على السياسة العالميَّة آنذاك. أرادت بريطانيا -على خلاف رغبة العثمانيِّين- في الانتهاء من الاتِّفاق قبل طلب الأميركان للمشاركة. كان العثمانيُّون يشعرون أن أميركا يمكن أن تُلَطِّف من الشروط، وكذلك كان يشعر الإنجليز، ولذلك أرادوا -أي الإنجليز- الإسراع[30]. كانت الدولة العثمانية تريد وقف الحرب بأيِّ ثمن، ولذلك وافقوا على الجلوس منفردين مع الإنجليز. الذي لم يكن معلومًا لدى العثمانيِّين أن الأمور الكثيرة (أربعة وعشرين طلبًا[31]) التي تسلَّمها الأدميرال كالثورب من رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد لويد چورچ David Lloyd George كانت كلُّها قابلةً للتفاوض باستثناء احتلال المضايق البحريَّة[32]! هذا يعني أن المفاوِض العثماني كان يمكن أن «يضغط» على الإنجليز لكي يُخفِّف الشروط كثيرًا، ولكنَّه لم يفعل، ليس لغياب الوطنيَّة؛ فرءوف بك من الرجال الحريصين على مصلحة الدولة، وسنرى له مواقف مهمَّة في سياق الأحداث، ولكن غالبًا للحالة النفسيَّة المنهارة التي كانت عليها الحكومة العثمانيَّة، خاصَّةً أنها حكومةٌ جديدة لم تتسلم الإدارة إلا منذ أسبوعين[33]، وكان همُّها الأوَّل والأخير هو إنهاء الحرب المدمِّرة، ولذلك ظهر واضحًا أن الوزير أُعْطِي صلاحيَّاتٍ كبرى للاستسلام تحت أيِّ شرط!
كانت شروط الاستسلام قاسية[34][35][36]، جد قاسية! وتشمل الآتي:
1. احتلال مضايق البوسفور والدردنيل، والسماح لسفن الحلفاء فقط بالمرور منها.
2. تسريح الجيش العثماني.
3. وضع رقابة الحلفاء على الإذاعة والتلغراف.
4. السماح للحلفاء باستخدام كافَّة الطرق الحديديَّة في الدولة.
5. استسلام القوَّات العثمانيَّة في الولايات العربيَّة كلِّها (اليمن، العراق، الشام، الحجاز).
6. انسحاب القوَّات العثمانيَّة في حدودها الشرقيَّة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب، وهذا يعني تضييع مكاسب معاهدة برست-ليتوڤسك مع الروس، وبالتالي التنازل عن قارص وباطوم، وسيقوم الحلفاء باحتلال باطوم.
7. من حقِّ الحلفاء احتلال أيَّة مواقع استراتيجيَّة في داخل الدولة العثمانية إذا استجدَّت ظروفٌ تهدِّد أمنهم. (هذا بندٌ في غاية الغموض، وهو لا يعني إلَّا الاستسلام غير المشروط!)
8. إعادة أسرى الحلفاء دون أيَّة شروط، وإبقاء أسرى العثمانيِّين تحت تصرُّف الحلفاء. (هذا بندٌ في غاية الإذلال!)
9. من حقِّ القوَّات الإنجليزيَّة الدخول إلى المناطق الأرمينيَّة في شرق الأناضول لإعادة النظام إليها في حال حدوث اضطرابات.
10. على الدولة العثمانية أن تمدَّ قوَّات الحلفاء بالفحم، والمؤن الغذائيَّة مجانًا!
كانت هذه اتفاقيَّةً مبدئيَّة، لم تُرْسَم فيها حدود، ولم تُحَدَّد فيها علاقاتٌ مستقبليَّة، ولكنَّها كانت فقط لإنهاء الحرب، وذلك إلى أن يُعقَد مؤتمرٌ كبيرٌ لاحقًا، لإقرار الوضع النهائي للدولة العثمانيَّة، وعلاقاتها بالأقطار التي كانت تابعةً لها قبل انتهاء الحرب. كانت الاتفاقيَّة مهينةً بشكلٍ كبيرٍ للدولة العثمانيَّة، وتمَّت آليَّاتها بشكلٍ يُسبِّب الإذلال المتعمَّد للمنهزمين، إلى درجة أن الطلب الوحيد الذي طلبه العثمانيُّون كان الحصول على دعمٍ ماليٍّ من الحلفاء عوضًا عن الدعم الألماني لأن البلاد في حالة إفلاس، ومع ذلك رفض الإنجليز إجابة هذا الطلب! وعندما طلب رءوف بك تأجيل التوقيع قليلًا إلى أن يحصل على موافقةٍ من السلطان والصدر الأعظم على البند الذي يقضي باحتلال أيِّ جزءٍ من الدولة العثمانية عند الحاجة رفض كالثورب، ووضع موعد التاسعة مساءً حدًّا أقصى للموافقة على الهدنة، فاضطرَّ رءوف بك إلى التوقيع[37]!
هكذا تمَّ الاتِّفاق المذل!
لم تُذْكَر إسطنبول العاصمة في الهدنة، وإن كان احتلال المضايق يجعل احتلال العاصمة أمرًا متوقَّعًا. -أيضًا- غموض البند الذي يسمح باحتلال أيِّ جزءٍ في الدولة العثمانية يجعل إسطنبول مستهدَفةً بشكلٍ مباشر[38]!
من الجدير بالذكر أن الباشوات الثلاثة؛ أنور، وطلعت، وجمال، وهم المسئولون الرئيسون عن مأساة دخول الدولة العثمانية هذه الحرب المهلكة، هربوا بعد الهدنة المخزية بيومين -في أوَّل نوفمبر 1918- على متن سفينةٍ ألمانيَّةٍ إلى أوديسا بروسيا، ومنها إلى برلين[39]! لم يكن ممكنًا لهم أن يعيشوا في الدولة بعد هذه الكارثة الماحقة!
احتلال إسطنبول (1918م):
أقنعت الحكومة العثمانية شعبها أن الشروط التي أوقفت بها الحرب شروطٌ متساهلة، وغير واقعيَّة، ولن تُنفَّذ على الحقيقة إلَّا في أطرٍ ضيِّقة[40]. هذا لكي يتم الاستسلام في هدوء دون اضطرابات، حتى لا تتجدَّد الحرب المهلكة. اقتنع الشعب -أو أقنع نفسه- لبرهة، ولكنَّه صُدِمَ في يوم 13 نوفمبر 1918م[41][42] بأبواب إسطنبول الحصينة تُفْتَح -للمرَّة الأولى منذ زمن السلطان محمد الفاتح- لجيوش الحلفاء!
هذه أتعس لحظةٍ في تاريخ المدينة العظيمة منذ فَتْحِها على يد العظيم الفاتح في 29 مايو 1453!
وقف المواطنون المساكين، بلا حيلة، يُشاهدون القوَّات العسكريَّة للأعداء تنساب بهدوء داخل المدينة التليدة، التي كان يسعد سفراء الدول الأجنبيَّة بدخولها -يومًا ما- لأجل لقاء السلاطين العظماء، ولكن هكذا الأيام دُوَلٌ! قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: 118].
انسابت إلى داخل إسطنبول جيوش فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، ووُضِعَت بذلك إسطنبول تحت الإدارة العسكريَّة للحلفاء جميعًا[43]. لم يكن الحلفاء على وفاق، وكان بين قادتهم مشاحناتٌ مستمرَّةٌ نتيجة الرغبة في الهيمنة، وإن كانت اليد العليا كانت للإنجليز. لئلَّا يتفاقم النزاع بين الحلفاء قاموا «بتقطيع» إسطنبول بينهم! قُسِّمَت المدينة العريقة إلى ثلاث مناطق إداريَّة؛ الأولى هي إسطنبول القديمة غرب مرمرة تحت إدارة فرنسا، والثانية إسكودار شرق مرمرة تحت إدارة إيطاليا، والثالثة جالاتا شمال القرن الذهبي تحت إدارة بريطانيا[44]، أمَّا القائد العام للمدينة فكان الإنجليزي كالثورب الذي وَقَّع هدنة مودروس[45].
احتلال الموصل (1918م):
يأخذ احتلال الإنجليز لمدينة الموصل العراقيَّة أهميَّةً خاصَّة؛ لأنه حدث في يوم 10 نوفمبر 1918م[46]، أي بعد هدنة مودروس بعشرة أيَّام، وذلك في الفترة التي تعاهد فيها الطرفان -العثماني والحلفاء- على وقف كلِّ الأعمال العدائيَّة. كان الاحتلال الإنجليزي رمزًا للغدر المتكرِّر الذي تقوم به القوى الأوروبِّيَّة المختلفة مع الدولة العثمانيَّة. كانت بريطانيا تعلم أن منطقة الموصل واعدةٌ بخصوص احتمال وجود حقول نفطٍ كبرى بها، فأرادت أن تُدْخِلها تحت احتلالها من الآن حتى لا يُتفاوَض عليها لاحقًا[47]. -أيضًا- كان الإنجليز ينظرون إلى جبال الموصل الشماليَّة على أنها حمايةٌ طبيعيَّةٌ مهمَّةٌ لأملاكهم في العراق المحتل، كما أنها تُمَثِّل منطقةً استراتيجيَّةً مهمَّة تكفل الوصول الجيِّد لإيران، والقوقاز، والأناضول معًا[48]. بالنسبة إلى العثمانيِّين فإنهم كانوا ينظرون إلى جبال الموصل على أنها مكانٌ رئيسٌ لتجمُّع الأكراد، ومِنْ ثَمَّ كانوا يريدون السيطرة عليه لئلَّا يحدث تعاونٌ بين أكراد الموصل وأكراد الأناضول، والذي يمكن أن يُهدِّد الأمن القومي للدولة[49].
لم تُجْدِ الاعتراضات العثمانيَّة، وفرضت بريطانيا الوضع الذي تريد بالقوَّة[50]، وظلَّت المسألة مشتهرةً في المحافل الدوليَّة تحت عنوان: «مسألة الموصل» Mosul Question، ولم تُحْسَم بشكلٍ كاملٍ إلَّا في عام 1926م لصالح الإنجليز، أي اعتبرت جزءًا من العراق[51][52][53]، المحتل آنذاك من بريطانيا.
احتلال جنوب شرق الأناضول (1918م):
في شهور ديسمبر 1918 ويناير وفبراير 1919، قامت القوَّات البريطانيَّة والفرنسيَّة باحتلال عدَّة مدنٍ في جنوب شرق الأناضول، فاحتلَّت بريطانيا مدن كيليس Kilis، وعنتاب، ومرعش، واحتلَّت القوَّات الفرنسيَّة مدن أنطاكية، ومِرسين Mersin، وطرسوس، وأضنة[54][55][56]. بعد ذلك ستقوم بريطانيا بتسليم كلِّ المدن التي احتلتها لفرنسا لتُصبح منطقة نفوذٍ فرنسيَّة[57]. كان من الواضح أن هذه الاحتلالات كانت تتمُّ وَفْقَ الحدود التي اتَّفق عليها الإنجليز والفرنسيون في معاهدة سايكس- بيكو عام 1916، وهي التي سيُؤكَّد عليها -لاحقًا- في معاهدة سيڤر عام 1920م.
احتلال إزمير (1919م):
كانت هناك حالة احتقانٍ شديدةٍ في الدولة العثمانية، خاصَّةً في الأناضول وإسطنبول؛ فهذه المناطق هي الوطن الأم للدولة العثمانية، وهي التجمُّع الرئيس للأتراك، كما أنها لم تشهد في تاريخها الإسلامي كلِّه أيَّ احتلالٍ أجنبي، ومع ذلك كان الشعب، وبقايا الجيش، يكظمون الغيظ؛ لعلَّ الوعود التي أطلقتها الحكومة العثمانية سابقًا -من أن هذا كلَّه أمرٌ مؤقَّت- تكون صادقة، وينتهي هذا الكابوس المخيف. كان الوضع كذلك إلى أن بوغت العثمانيُّون بالقوَّات اليونانيَّة تغزو إزمير غرب الأناضول في 15 مايو 1919م[58]!
كانت الأطماع اليونانيَّة في غرب الأناضول كبيرة، وكانت إيطاليا تُنافس اليونان في هذا الشأن، وانتظر الطرفان حسم الأمر عند اجتماع الحلفاء المنتصرون لبحث تقسيم غنائم الحرب! عُقِدَ مؤتمر باريس للسلام[59] Paris Peace Conference، ويعرف -أيضًا- بمؤتمر ڤرساي للسلام Versailles Peace Conference، بدايةً من يوم 18 يناير 1919م[60]، واستمرَّ ستَّة أشهر كاملة[61]، وكان بحضور عددٍ كبيرٍ من الأمم التي حالفت الدول المنتصرة، ومع ذلك فالقرارات كلُّها كانت في أيدي «الأربعة الكبار»؛ بريطانيا، وفرنسا، وأميركا، وإيطاليا، مع مشاركةٍ نسبيَّةٍ للقوَّة الخامسة الكبرى في العالم آنذاك وهي اليابان[62]. كانت هذه هي القوى التي تحكم العالم في هذه الحقبة التاريخيَّة التالية للحرب العالمية الأولى. نوقشت في هذا المؤتمر تفاصيل الحدود التي تفصل بين ممتلكات كلِّ دولةٍ من دول الحلفاء المنتصرين. كانت معظم الأراضي المغنومة من الدولة العثمانية أو ألمانيا، متجهةً لصالح بريطانيا أو فرنسا[63]. اختلف الوفدان اليوناني والإيطالي على ملكيَّة غرب الأناضول، وانتهى الأمر لصالح اليونان بعد وقوف بريطانيا وفرنسا إلى جانبها، ومِنْ ثَمَّ بدأت اليونان في احتلال إزمير مباشرةً دون تأخير؛ لتفرض الواقع على إيطاليا[64]. أقدمت أميركا -أيضًا- على دعم اليونانيين في احتلال إزمير وغرب الأناضول[65]. هكذا كانوا يتنافسون على تقسيم أرض الدولة العثمانية دون وجود ممثِّلٍ أصلًا عن العثمانيِّين!
لم يتحمَّل الأتراك دخول الجيش اليوناني إلى أراضيهم[66]! كان هذا بمثابة القشَّة التي قصمت ظهر البعير! كان التنافس العرقي بين الأتراك واليونانيين كبيرًا، والتاريخ يشهد صراعاتٍ تاريخيَّةً قديمةً بين الطرفين، ولا ننسى أن البيزنطيين يونانيون، كما أن العثمانيِّين كانوا ينظرون بازدراء إلى الجيش اليوناني الضعيف، ولم يتوقعوا أن يعيشوا إلى أن يُشاهدوا هذا الجيش يغزو بلادهم الأم!
لم يكن هذا الوضع المؤسف مقبولًا عند «الشعب» العثماني، وإن كانت الحكومة -السلطان، والوزراء- قد قبلوه[67]! أطلق صحفيٌّ عثمانيٌّ اسمه حسن تحسين رصاصةً على حامل الراية في مقدِّمة الجيش اليوناني فأردته قتيلًا! عُرِفَت هذه الرصاصة «بالرصاصة الأولى»، وكانت أوَّل علامةٍ للمقاومة ضدَّ الاحتلال، وكانت في اليوم نفسه الذي دخلت فيه القوَّات اليونانيَّة، 15 مايو 1919م. قتل اليونانيون حسن تحسين فورًا، فكان أول شهداء مقاومة الاحتلال[68]. تَبِع ذلك قتل لواءٍ في الجيش اسمه سليمان فتحي، وقد رفض هذا اللواء أن يُردِّد: «يحيا ڤينيزيلوس» Zito Venizelos، وإليفتهيريوس ڤينيزيلوس Eleftherios Venizelos هو رئيس الوزراء اليوناني آنذاك، وهو من رموز حركة التحرُّر اليونانيَّة. إزاء هذا الموقف من الضابط العثماني طعنه الجنود اليونانيون مرارًا بالحراب حتى سقط شهيدًا، ولم يقف الأمر عند هذا الحدِّ، بل قتل اليونانيون عددًا من الجنود العزَّل في قاعدة الجيش الرئيسة في المدينة بعد استسلامهم ورفع الأعلام البيضاء[69]! -أيضًا- قُتِل في اليوم الأوَّل عددٌ كبيرٌ من المدنيِّين يُقدَّر في الروايات الغربيَّة بثلاثمائة إلى ستمائة[70]، بينما ترتفع التقديرات التركيَّة بالرقم في أوَّل أيَّام الاحتلال إلى أكثر من ألفي قتيل[71]. كان جميع القتلى تقريبًا من أصولٍ تركيَّة، ممَّا يحمل بوضوح صبغة «التطهير العرقي»، وقد شارك السكان اليونانيون (وهم كثرٌ في هذه المنطقة من غرب الأناضول) في عمليَّات قتل الأتراك، وحرق القرى ذات الأغلبيَّة التركيَّة[72]! في أقلَّ من شهرين وسَّعت القوَّات اليونانيَّة من دائرة احتلالها فشملت عدَّة مدنٍ مهمَّةٍ في المنطقة؛ مثل مانيسا، وآيدن، ونازيلي Nazilli، وقد حدثت في عددٍ من هذه المدن مجموعةٌ من المذابح ضدَّ الأتراك[73].
أشعلت هذه المواقف المستفزَّة مشاعر الغضب عند الشعب، وبدأت الإرهاصات التي ستقود إلى قيام الحركة الوطنية التركية.
نشأة الحركة الوطنية التركية (1919م):
كان من الطبيعي أن يُصاب الشعب بحالةٍ من الاضطراب بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، وكان من الطبيعي أن تكون خطواته متخبِّطة، وأفكاره مشتَّتة، وكان الجميع يُدرك أنه لا ينبغي قبول هذا الوضع، ولكن ردود فعلهم كانت عشوائيَّة؛ مثل تأسيس بعض جمعيَّات الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك للاعتراض القانونيِّ والدولي على انتهاكات الجيوش المحتلَّة[74]، ومثل بعض التظاهرات ضدَّ الاحتلال، كتلك التي شهدها ميدان السلطان أحمد في إسطنبول في 23 مايو 1919م ردًّا على احتلال اليونان لغرب الأناضول[75]. أخطر وأهم ردود الفعل كانت في قيام بعضهم بتسريب بعض الذخيرة البريطانيَّة من إسطنبول إلى الأناضول بغية استخدامها لاحقًا في المقاومة المسلَّحة ضدَّ الحلفاء[76]، و-أيضًا- تحريك علي فؤاد باشا -وهو قائد الفرقة العشرين من الجيش العثماني- لفرقته من إيرجلي Ereğli في جنوب الأناضول إلى أنقرة في شمال وسط الأناضول[77]؛ لتكون بعيدةً عن قوَّات الاحتلال في سواحل الأناضول الجنوبيَّة. لم يكن واضحًا لفؤاد باشا حينئذٍ ماذا سيفعل بقوَّاته، لكنَّها كانت خطوةً احترازيَّة.
وعلى الرغم من هذه الضبابيَّة في الرؤية في هذه المرحلة فإنَّني أحسب أن معظم الشعب وصل إلى عدَّة نتائج مبدئيَّة من خلال التجربة الأليمة التي مرَّت بها الدولة في الشهور والسنوات السابقة. كانت أهمُّ هذه النتائج ثلاثًا؛ النتيجة الأولى هي أن الاحتلال العسكري -سواء اليوناني في غرب الأناضول، أم الفرنسي في جنوبه- لن يخرج إلا بالقوَّة المسلحة؛ لأن غدر الأوروبِّيِّين في المفاوضات صار فاضحًا، ولأن منطق القوَّة يفرض نفسه، والغرب ينتظر فرصة احتلال الدولة العثمانيَّة منذ قرون، فلن يُضيع الآن هذه الفرصة على طاولة المفاوضات. والنتيجة الثانية هي أن الحكومة الحاليَّة -المتمثلة في السلطان، والصدر الأعظم، والوزراء، وقادة الجيش الكبار- لن يستطيعوا فعل شيءٍ في هذه الأزمة؛ فهم الذين أغرقوا الأمَّة في هذا المستنقع العميق، وهم الذين أخذوا قرار الاستسلام في مودروس، وهم الذين فتحوا أبواب إسطنبول للأعداء، وهم الذين راقبوا في صمت دخول القوَّات اليونانيَّة إلى غرب الأناضول مع ارتكاب المذابح ضدَّ الأتراك المسلمين.
لا يُرْجَى من وراء هؤلاء شيء، حتى لو كانت عندهم «الرغبة» في الخلاص، فليست عندهم «القدرة»! حتى السلطان الذي يدَّعي «الخلافة» لم يبذل أيَّ جهدٍ لإثبات خلافته، بل كان خضوعه للأعداء أكبر من خضوعِ أيِّ فردٍ في الشعب العثماني! النتيجة الثالثة هي أن «العرق» الوحيد الذي ظلَّ صامدًا في هذه الأزمة مع الدولة العثمانية هو العرق «التركي»! كانت الدولة العثمانيَّة تضمُّ أعراقًا شتَّى، ولكن صار كلُّ عرقٍ يبحث عن «مصلحته» الخاصَّة تاركًا العثمانيِّين وحدهم أمام العاصفة الأوروبِّيَّة! إنَّنا يمكن أن نتفهَّم رغبة الأعراق النصرانية في الخلاص من الحكم العثماني الإسلامي، كالأعراق الأرمينيَّة، واليونانيَّة، والبلغاريَّة، والصربيَّة، والمقدونيَّة، والرومانيَّة، لكنَّنا شاهدنا كذلك الأعراق الإسلاميَّة تترك الدولة العثمانيَّة في هذه الأزمة! البوسنة ثارت عليها، وكذلك فعل الألبان، ومثلهم فعل العرب في ثورتهم الكبرى، التي حاربوا فيها الدولة العثمانيَّة جنبًا إلى جنب مع الإنجليز! أمَّا الأكراد المسلمون فكانوا يُطالبون -أيضًا- بدولة «كردستان Kurdistan» التي ستأخذ قسمًا من الدولة العثمانية في شرق الأناضول، وشمال العراق[78]. ماذا يفعل العثمانيُّون في هذا الموقف؟! الحقُّ إنَّه من الطبيعي -وإن لم يكن هو الأمثل- أن ينشط دعاة القوميَّة «التركيَّة» في هذه الأجواء. لم يعد هذا تفكيرًا استراتيجيًّا للمستقبل، ولا مجرَّد عصبيَّة للعرق؛ إنما كان «الواقع» الذي تعيشه الدولة.
لقد ضاعت كلُّ الأقطار، ولم يبقَ إلا الأناضول، وإسطنبول، وتراقيا الشرقية (غرب إسطنبول)، وهذه المناطق لا يعيش فيها إلا «الأتراك»، وقليلٌ من الأرمن، واليونانيين، والأكراد، وكلهم راغبٌ في الانفصال. كانت هذه هي النتائج التي وصل إليها «أهل الأناضول، وإسطنبول» في هذه المرحلة، ولكن لم يكن عندهم التصوُّر العملي للخروج من الأزمة بناءً على هذه النتائج.
ظلَّت هذه الرؤية ضبابيَّةً إلى أن ظهر في الصورة مصطفى كمال باشا (أتاتورك)؛ حيث كانت له القدرة الفائقة على بلورة كلِّ هذه النتائج في شكل خطَّةٍ واضحة المعالم، لها هدفٌ محدَّد، وتعتمد على أساليب عمليَّة، وتعمل من خلال أطرٍ زمنيَّةٍ منطقيَّة. قد يختلف المحلِّلون التاريخيُّون حول شخصيَّة مصطفى كمال، وتوجُّهاته، ومنطلقات أعماله، لكنَّ الجميع يتَّفق على ذكائه، ومهارته، وقدرته على تحقيق أهدافه بأقلَّ خسارةٍ ممكنة، كما يتَّفقون على مهاراته القياديَّة والإداريَّة الفريدة[79]، التي مكَّنته من تحقيق نجاحٍ كبيرٍ لا يتناسب مع الإمكانات الفقيرة التي كانت في يده آنذاك.
كان مصطفى كمال قد حقَّق شهرةً واسعةً بعد نصر جاليبولي المهيب، الذي كان له دورٌ كبيرٌ في تحقيقه[80]، كما اشتُهر مصطفى كمال بأنَّه القائد العثماني الوحيد الذي لم تتلقَّ فرقته هزيمةً مباشرةً قط في كلِّ حروبه، سواءٌ في الحرب العالمية الأولى، أم في البلقان قبلها[81]. هذه الشهرة أهَّلته لأن يمنحه السلطان محمد السادس في 30 أبريل 1919م[82] منصب المفتِّش العام في الجيش التاسع في سامسون، وكلَّفه بالسفر إلى هناك لاستعادة النظام، وتسوية الاضطرابات بين المسلمين والمسيحيين، ونزع السلاح، وتفريق العصابات شبه العسكريَّة التي كانت تنشط في المنطقة، وبصفةٍ عامَّة الإشراف على نزع السلاح، و-أيضًا- تسريح القوَّات العثمانيَّة المتبقية[83]. كان هذا التكليف قبل الاحتلال اليوناني لإزمير. سافر مصطفى كمال لأجل هذه المهمَّة بالبحر[84] إلى سامسون بشمال الأناضول، فوصلها في 19 مايو[85]، حيث سمع أنباء الاحتلال اليوناني لغرب الأناضول. أخذ مصطفى كمال قرارًا سريعًا وحاسمًا بتجميع الجهود لتحرير البلاد من الاحتلال اليوناني وغيره[86]. كان القرار صعبًا لأنه سيتضمَّن مواجهةً لحكومة البلاد، بما فيها السلطان، ومع ذلك فالحسم الذي تميَّز به مصطفى كمال لم يترك أمامه فرصةً للتردُّد.
كانت الفكرة الرئيسة التي تشغل مصطفى كمال في هذا الوقت هي تحرير البلد من المحتلِّين، فبدأ من يوم وصوله إلى سامسون -وهو يوم 19 مايو 1919م- في تجميع الأنصار لفكرته، وذلك من رجال الجيش، وغيرهم من كبار رجال الدولة، وعامَّة الشعب، ولهذا يُعتبر هذا التاريخ -19 مايو 1919م- عند عامَّة المؤرِّخين هو بداية حرب الاستقلال التركيَّة[87]. أدركت المخابرات الإنجليزيَّة مبكرًا التحوُّل الذي طرأ على مصطفى كمال، وقامت بمداهمة بيت والدته القاطنة في إسطنبول آنذاك، وبحثت عن وثائق تدين مصطفى كمال، وعثرت على قائمةٍ ببعض الأسماء التي كانت تتردَّد عليه، وهي أسماءٌ سيثبت لاحقًا أنهم سيُشاركون في الحركة الوطنيَّة لتحرير تركيا[88]. في غضون شهرٍ تقريبًا كان قد وصل إلى عددٍ من الرموز النضاليَّة، كان أهمُّهم رءوف بك[89]، وهو وزير الشئون البحريَّة الذي وقَّع هدنة مودروس؛ فقد استقال وانضمَّ إلى حركة مصطفى كمال[90].
-أيضًا- من الرموز المهمَّة جدًّا قائدان عسكريَّان كبيران؛ الأوَّل هو علي فؤاد باشا، وهو قائد الفرقة العشرين المتمركز الآن في أنقرة، والثاني هو كاظم كارابيكير Kâzım Karabekir قائد الفرقة الخامسة عشرة المتمركز في إرضروم. كانت أهميَّة هذين القائدين أنهما انضمَّا إلى الحركة بجنودهما ممَّا أعطاها قوَّةً عسكريَّةً كبيرة[91]. أدركت المخابرات البريطانيَّة هذه التحرُّكات، ومِنْ ثَمَّ طلب الحاكم العسكري لإسطنبول كالثورب من وزير الحربيَّة العثماني شوكت باشا إعفاء مصطفى كمال من مهمَّته، فأرسل وزير الحربيَّة يستدعيه، ولكن مصطفى كمال ماطل في الإجابة لكسب الوقت[92]. تزايد عدد المنضمِّين إلى الحركة، وعُقِد اجتماع في أماسيا في 21 يونيو 1919م، نتج عنه منشورٌ مهمٌّ في يوم 22 يونيو عُرِفَ بمنشور أماسيا Amasya Circular، وفيه يدعو كاتبو المنشور جميعَ أفراد الشعب للمشاركة في النضال ضدَّ الأعداء لتحرير البلاد، ويُصرِّحون فيه بأن الحكومة الرسميَّة لن تستطيع فعل شيء، وأن الذي يمكن أن يُحرِّر البلاد لا بُدَّ أن يكون حرًّا لا يقع تحت أيِّ ضغوط[93]، وقد دعا هذا المنشور لعقد مؤتمرٍ جامعٍ لاحقًا في مدينة سيواس Sivas[94].
لم يقم وزير الحربيَّة حتى هذه اللحظة بإعفاء مصطفى كمال من وظيفته، واستغل مصطفى كمال ذلك في 7 يوليو 1919م فأرسل إلى قيادات الجيش التابع لسلطته منشورًا يدعوهم فيه إلى عدم تسليم السلاح، والبقاء على قوَّتهم إلى أن يقوموا بتحرير البلاد من المحتلين. اعتبر كالثورب ذلك تحريضًا على جيوش الحلفاء، ومِنْ ثَمَّ أمر وزير الحربيَّة العثماني في يوم 8 يوليو بتوقيف مصطفى كمال[95]، وهنا اضطر مصطفى كمال في اليوم نفسه -8 يوليو- إلى الاستقالة من الجيش ليكون حرًّا في قيادته للحركة الوطنيَّة[96][97].
عُقِدت مؤتمرات مرحليَّة تحضيريَّة لمؤتمر سيواس، كان أهمُّها مؤتمر شرق الأناضول، في مدينة إرضروم، في الفترة بين 21 يوليو و7 أغسطس، والذي اختير فيه هيئة تمثيليَّة تتحدَّث باسم الحركة الوطنيَّة، وكان مصطفى كمال على رأسها، كما عُمِلت فيه مسودات تحضيريَّة لمؤتمر سيواس[98].
عُقِد مؤتمر سيواس الكبير في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر 1919م[99]. كان الحضور كلُّهم من عرقيَّةٍ تركيَّة، ولم يكن فيهم كرديٌّ واحد، بل تزامن مع عقد المؤتمر اكتشاف محاولاتٍ كرديَّةٍ لإقامة دولةٍ مستقلةٍ لهم تحت حماية الإنجليز[100]. هذا بلا شَكٍّ عزَّز الفكر القومي عند الوطنيِّين الأتراك. في مؤتمر سيواس أقرَّت الهيئة الرسميَّة التي تتحدَّث باسم الحركة الوطنية التركية Turkish National Movement، ووُضِع على رأسها مصطفى كمال، وكانت تبدو في تشكيلها كأنها الحكومة المستقبليَّة لتركيا[101]، كما أُصدرت وثيقةٌ تُعْرَف «بالميثاق الوطني» (بالإنجليزية: National Pact، وبالتركية: Misak-ı Millî)[102]، وهي وثيقةٌ تحدِّد بعض المنطلقات المهمَّة التي ستسعى الحركة إلى تحقيقها.
الميثاق الوطني:
كانت منطلقات الميثاق الوطني[103][104][105]؛ كالآتي:
1. سيتحدَّد مستقبل البلاد العربيَّة بناءً على استفتاءٍ يُجْرَى فيها، بمعنى أن مصيرها متروكٌ بحرِّيَّةٍ لأهلها، أمَّا البلاد الباقية ضمن حدود الوطن التركي والتي يسكنها أكثريَّةٌ إسلاميَّة عثمانيَّة عظمى متَّحدة في الدين والجنس والأصل، والتي يربطها ببعضها تضامنٌ قائمٌ على وحدة المصلحة السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، فإنها لا تقبل التجزئة لأيِّ سبب. (هذا يعني أن الأرض الأصليَّة للدولة هي الأرض التي يعيش عليها الأتراك -ومعهم الأكراد ضمنًا- وهي غير داخلةٍ في الاستفتاء، وهذا يوضِّح الرؤية عند الحركة الوطنية التركية، التي صارت بشكلٍ غير مباشرٍ تعترف بأن الدولة التركيَّة -أو العثمانية آنذاك- هي الأناضول، وإسطنبول، وتراقيا الشرقية، أمَّا البلاد العربيَّة فهي تابعة، ويمكن أن تكون مستقلَّةً إذا أرادت بالاستفتاء، والواقع أن هذه الرؤية منطقيَّة وواقعيَّة في هذه الحقبة، على الرغم من أنها لا تتوافق مع مفهوم «الخلافة» الجامع لكلِّ المسلمين، ولكن هذا المفهوم الأخير كان «مثاليًّا» غير قابلٍ للتطبيق، على الأقل في هذه المرحلة، التي تُعاني فيها الأمَّة من الاحتلال في كلِّ بقاعها).
2. سيتحدَّد مستقبل قارص، وأرداهان، وباطوم، عن طريق الاستفتاء كذلك. (هذه مدنٌ على الحدود التركيَّة، ويمكن أن تكون تابعةً للأتراك، أو للچورچيين، أو للأرمن، أو للروس. بمعنى أنه يمكن الرجوع للاستفتاء، وليس حتميًّا أن تكون لتركيا؛ أي أنها تابعةٌ وليست أصليَّة. الآن تقع قارص، وأرداهان داخل الحدود التركيَّة، بينما توجد باطوم في دولة چورچيا).
3. سيتحدَّد مستقبل تراقيا الغربية باستفتاء خاص بأهلها. (هذه المنطقة تحت حكم اليونان منذ حروب البلقان، ومعنى هذا أن الحركة الوطنية تريد فتح ملفَّاتٍ قديمة، ومناقشة أمورٍ حُسِمت سابقًا، وأعتقد أن السبب في إدخال تراقيا الغربية في الميثاق هو الضغط على اليونان، فكما يُطالب اليونانيون بغرب الأناضول، فالأتراك يطالبون بتراقيا الغربية).
4. لا بُدَّ أن يُراعى أمن إسطنبول وبحر مرمرة، وستُحدَّد قواعد المرور التجاري في البوسفور والدردنيل بمعرفة تركيا، والدول المعنيَّة. (لم يُحدِّد الميثاق مَنْ هي هذه الدول).
5. ستُحفظ الحقوق للأقليَّات في الدولة بشرط أن تُحفظ حقوق الأقليَّات المسلمة في البلاد المجاورة.
6. لكي تتقدَّم الدولة في كافَّة المجالات لا بُدَّ أن تكون مستقلَّةً وحرَّة، وأن تُزال عنها كلُّ القيود سواءٌ في مجال السياسة، أم القضاء، أم الاقتصاد، وهذا يتضمَّن إلغاء الامتيازات الأجنبيَّة، وسيُنسَّق في مسألة سداد الديون العثمانيَّة مع الولايات التي كانت تابعةً للدولة العثمانية وقت الاستدانة.
في هذا الميثاق يظهر وضوح الرؤية عند القائمين عليه، على الأقل من وجهة نظرهم؛ فهم ينظرون إلى «الدولة التركيَّة» على أنها الدولة التي يعيش عليها الأتراك -وأيضًا الأكراد- في الأناضول، وإسطنبول، وتراقيا الشرقية، أمَّا ما عدا ذلك من الأراضي فهي تابعة، ويمكن -إذا أرادت- أن تنفصل عن الدولة التركيَّة. هذه الدولة لا بُدَّ أن تكون حرَّةً (وهذا يعني إخراج الإنجليز، والفرنسيين، واليونانيين، والإيطاليين، من البلاد)، وستكون دولةً محافظةً على حقوق الأقليَّات النصرانية (الأرمن واليونان) بشرط حفظ حقوق المسلمين في البلاد المجاورة (المقصود أرمينيا، واليونان). يمكن تلخيص الميثاق الوطني في أنه يرسم حدود «تركيا» الجديدة، ويُقرِّر حتميَّة استقلالها.
كان تفاعل الشعب مع الميثاق إيجابيًّا، إلى درجة أنه عُقِدت مؤتمراتٌ في بعض المناطق لدعم الحركة الوطنيَّة، وتأييد مصطفى كمال، وذلك دون الرجوع إليه؛ بمعنى أن هذه المؤتمرات لم تكن بتنسيقٍ معه، وكان من أهمِّ هذه المؤتمرات وأخطرها مؤتمر ألاشيهير Alaşehir، في الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر 1919، ووجه خطورته أنه عُقِد في مكانٍ قريبٍ جدًّا من نفوذ الاحتلال اليوناني غرب الأناضول[106].
بروتوكول أماسيا:
كان الميثاق الوطني من القوَّة بحيث اضطُرَّت الحكومةُ في إسطنبول إلى عدم تجاهله، فأرسل الصدرُ الأعظم علي رضا باشا مندوبًا من طرفه (طرف الدولة)، وهو صالح خلوصي باشا وزير الشئون البحريَّة الحالي، ليتفاوض مع زعماء الحركة الوطنيَّة حول ما يمكن عمله بخصوص هذا الميثاق. كان وفد الحركة الوطنيَّة مكوَّنًا من مصطفى كمال باشا، ورءوف بك، وبكير سامي كوندوه بك[107][108]، وقد التقى الوفدان في أماسيا، وبعد مفاوضاتٍ وُقِّع اتِّفاقٌ بينهما في 22 أكتوبر 1919[109]، يقضي بضرورة العمل المشترك بين الحكومة و«الثوَّار» من أجل الحفاظ على وحدة الدولة. وصل الفريقان إلى صيغةٍ مشتركةٍ عُرِفَت «ببروتوكول أماسيا» Amasya Protocol. في هذا البروتوكول وافق الطرفان على قيام الدولة بإجراء انتخاباتٍ جديدةٍ لمجلس النواب في أكتوبر ونوفمبر 1919م، ثم يقوم المجلس بالنظر في أمر الميثاق الوطني، وينقاد الجميع إلى ما سيُقرِّره المجلس الجديد[110]. كان هذا يعني أن الحركة الوطنيَّة سوف تنهار إذا أقرَّ المجلس الجديد ببطلان الميثاق الوطني[111]، ومع ذلك وافق الثوَّار، ويبدو أنهم كانوا مطمئنِّين إلى أن الشعب سيختار ممثِّلين عنه يدعمون رؤيته، وفي هذا في الواقع مغامرةٌ كبرى!
كان البروتوكول جيدًّا من حيث الجانب النظري، أمَّا من الناحية العمليَّة فالأمر يعتريه أخطارٌ كبرى؛ فإجراء الانتخابات واجتماعات المجلس الجديد في ظلِّ الاحتلال الإنجليزي لن يكون أمرًا سهلًا، كما أن الحكومة الحاليَّة -المتمثِّلة في السلطان والوزراء- منصاعةٌ تمامًا لأمر الإنجليز، ولا تعمل بحرِّيَّةٍ كالثوَّار، فمن المتوقَّع أن يكون البروتوكول غير عمليٍّ على أرض الواقع، لكنَّها على العموم كانت خطوةً جيِّدة.
البرلمان الجديد، والحرب التركية الفرنسية، والحكومة الثنائية:
جرت انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدَّد، وتمكَّن عددٌ كبيرٌ من أنصار الحركة الوطنية من النجاح في دخول المجلس[112]، وعقد المجلس أولى جلساته في 12 يناير 1920م[113]. في هذا الوقت كانت الحركة الوطنية تفرض نفسها كواقعٍ في حياة الناس عن طريق القتال ضدَّ الجيوش المعتدية، وذلك في انتظار ما ستئول إليه اجتماعات المجلس الجديد للنوَّاب. في 21 يناير 1920م بدأت القوَّات المسلحة للحركة في الحرب ضدَّ الفرنسيين في مرعش. انتهت الحرب في مرعش في 11 فبراير بانتصار الحركة الوطنيَّة، والسيطرة على المدينة، ومقتل مائةٍ وستِّين جنديًّا فرنسيًّا، غير الجرحى والمفقودين، وهذا هو أوَّل نصرٍ عسكريٍّ للحركة الوطنية[114]، ولهذا له مكانةٌ كبيرةٌ في التاريخ التركي[115]. اختار مصطفى كمال -على الأغلب- أن تكون حربه الأولى مع الفرنسيين في الجنوب، وليس مع اليونانيين في الغرب؛ لأن هذه الجبهة أضعف من الجبهة اليونانية المدعومة من الإنجليز، والقريبة من إسطنبول المحتلَّة، ومن دولة اليونان، بعكس الجبهة الفرنسيَّة التي يُقاتل فيها الفرنسيون بتحفُّظ؛ وذلك لإرهاقهم بعد الحرب العالمية الأولى، وأعدادهم قليلةٌ نسبيًّا، ومتفرِّقةٌ على مساحاتٍ واسعة، كما كان الفرنسيون يعتمدون على الأرمن في المنطقة، وهم أضعف من اليونانيين[116]. بذلك يستطيع جيش الحركة الوطنية أن يُحقِّق انتصارات، يُحقِّق بها هدف التحرير من ناحية، ويجذب له قلوب العامَّة من ناحيةٍ أخرى.
في هذه الأثناء اجتمع مجلس النواب الجديد، وأقرَّ الميثاق الوطني الذي أصدره الثوريُّون في سيواس قبل ذلك[117]، ونُشِر هذا الإقرار رسميًّا في 17 فبراير 1920م[118]. غضب الإنجليز بشدَّةٍ لهذا الإقرار، وقاموا بالضغط على السلطان محمد السادس ليُعلن أن الحركة الوطنية خارجةٌ عن القانون، لكنَّ هذا الإعلان لم يُغيِّر من الواقع شيئًا[119]. اضطرَّ الإنجليز إلى الدخول بقوَّاتٍ عسكريَّةٍ كبيرةٍ إلى إسطنبول في 16 مارس 1920م، وقاموا بمداهمة البرلمان، واعتقال عددٍ من النواب، ونفيهم إلى مالطة[120]، كما قاموا باحتلال عدَّة مراكز حيويَّة في العاصمة؛ منها وزارة الحربيَّة ووزارة البحريَّة، وإعلان الأحكام العرفيَّة[121].
إن الإنجليز لا يقبلون بالديموقراطيَّة أبدًا خارج حدود إنجلترا!
عَقَدَ النواب جلسةً ختاميَّة في 18 مارس ندَّدوا فيها بالقمع الإنجليزي، وأعلنوا توقف نشاطهم، واستفاد مصطفى كمال باشا من هذا التصعيد الإنجليزي، والسكوت السلطاني، فأعلن في 19 مارس -في اليوم التالي مباشرةً لتوقف أعمال البرلمان[122]- عن سعي الحركة الوطنية لتأسيس مجلس نوَّابٍ جديدٍ في أنقرة يُمثِّل تركيا دون ضغوط، ودعا أفراد المجلس القديم للمشاركة فيه إن أرادوا[123].
في 11 أبريل أخطأ السلطان خطأً شنيعًا؛ إذ حلَّ -تحت الضغط الإنجليزي- البرلمان رسميًّا[124]! كان الإنجليز يريدون أن تكون كلُّ الأمور في يد السلطان بلا معينٍ من الشعب، وبهذه الصورة يُصبح السلطان دميةً في أيديهم لا قدرة له على المقاومة. هذا الحلُّ لبرلمان إسطنبول أعطى البرلمان الذي يدعو إليه مصطفى كمال الفرصة أن يكون شرعيًّا (برلمان أنقرة)؛ لأنه سيصير الوحيد الذي يُمثِّل الشعب بشكلٍ حقيقي. ارتكب السلطان خطأً آخر؛ فبدلًا من احتواء الحركة، واستخدامها في الضغط السياسي على الإنجليز، إذا به يُصدر فرمانًا بعصيان مصطفى كمال، بل ويدفع شيخ الإسلام إلى إصدار فتوى في 10 أبريل -قبل حلِّ المجلس بيوم- بأن الجماعات الوطنيَّة المتعدِّدة في الأناضول هم من البغاة، وأن قتلهم واجبٌ على المسلمين[125][126]! كان السلطان بعمله هذا شبيهًا بأخيه السلطان عبد الحميد الثاني عندما أصدر فرمانًا بعصيان أحمد عرابي في مصر عندما حارب الإنجليز أصدقاء الدولة! دفعت هذه الفتوى بعض المتحمِّسين للسلطان -وخاصَّةً من الإسلاميِّين- إلى تكوين فرقةٍ عسكريَّةٍ تحت اسم «جيش الخليفة»، وذلك تحت قيادة أحمد أنزافور Ahmet Anzavur، وهو عسكريٌّ سابق، حيث دعت هذه الفرقة إلى حرب رجال الحركة الوطنيَّة، وكانت مدعومةً بشكلٍ مباشرٍ من السلطان والإنجليز[127]. ومع ذلك فأثر الفتوى العكسي كان أكبر؛ إذ أصدر مفتي أنقرة فتوى مضادَّة وقَّع عليها مائةٌ واثنان وخمسون من العلماء في الأناضول بأنَّ فتوى شيخ الإسلام غير مقبولة، وهذا نَشَرَ فِكْرَ الحركة الوطنيَّة بشكلٍ أكبر في الأناضول[128][129]، خاصَّةً أن انتصارات الحركة على الفرنسيين في جنوب الأناضول ما زالت مستمرَّة، وكان آخرها في 11 أبريل -اليوم التالي لفتوى شيخ الإسلام- حيث أخرجوا الجيش الفرنسي من مدينة أورفا[130].
هكذا تقع قوى الاحتلال أحيانًا في أخطاء فادحة بعنفها الشديد، وباستهتارها بالشعوب، ويقول المؤرِّخ الأميركي روديريك دافيسون Roderic Davison: «إذا كان الاحتلال اليوناني لإزمير عام 1919م هو الذي خَلَقَ الحركة الوطنية التركية، فإن الاحتلال الإنجليزي لإسطنبول في 1920م هو الذي أدَّى إلى تحويل هذه الحركة إلى حكومةٍ فاعلةٍ منفصلة»[131]! وفي الواقع أن رضوخ السلطان للاحتلال لم يكن مقبولًا بأيِّ صورةٍ من الصور، وكان الأكرم له لو أخذ جانب الوطنيِّين ولو كان على حساب حياته، أمَّا استخدامه بشكلٍ سافرٍ لردع أيِّ صورة مقاومةٍ للاحتلال فهذا خزيٌ لا ينبغي له أن يقبل به! وكان السلطان -أو الخليفة- بهذا الاستسلام الكامل يكتب شهادة وفاته، ووفاة العائلة العثمانيَّة برمَّتها!
تمَّت الانتخابات التي دعا لها مصطفى كمال بالفعل، وتأسَّس مجلس النواب الذي أُطْلِق عليه اسم «الجمعية الوطنية التركية الكبرى» Turkish Grand National Assembly (TGNA)، وهو الاسم الذي ظلَّ ساريًا إلى يومنا هذا[132]. عَقَدَ المجلس أوَّل جلساته في 23 أبريل 1920م[133]، وانتُخِب مصطفى كمال باشا رئيسًا للمجلس[134]. وبعد خمسة أيام -في 28 أبريل 1920- شكَّل المجلسُ الحكومةَ التركيَّةَ الأولى[135].
على الرغم من العداء الظاهر بين فريق مصطفى كمال والوطنيِّين الثوار وبين فريق السلطان المدعوم بالإنجليز، فإن الحكومة الجديدة حاولت ألَّا تُظهر العداء قدر الإمكان حتى لا تتعدَّد الصراعات الداخليَّة، وتصرف الدولة بذلك عن مهمَّة التحرير. هذا دفع المجلس الجديد إلى إعلان بعض الأمور التي يمكن أن تُلَطِّف من الأجواء المضطربة. أولًا أعلن المجلس في جلسته الافتتاحيَّة أن هدفه هو تحرير السلطان من الهيمنة الإنجليزيَّة[136]. ثانيًا أقسم مصطفى كمال في إعلانه الأوَّل إلى الشعب بعد انتخابه أن ما يُقال عن الوطنيِّين من أنهم متمرِّدون على السلطان هو افتراء، وأن كلَّ ما في الأمر أنهم يريدون أن يحفظوا بلدهم من المصير الذي واجهته الهند ومصر[137]. ثالثًا وأخيرًا، وفي خطوةٍ عمليَّة، دعا المجلسُ السلطانَ إلى الاعتراف بالمجلس الجديد، ولكنَّه رفض[138]، وكان هذا خطأً منه، ولو قَبِلَ لوجد له وللعائلة العثمانية مكانًا في الوضع الجديد، أمَّا برفضه فإنه صار خارج الصورة التركيَّة، وفي حال ما إذا تغلَّب الإنجليز على الثوَّار فإنه سيصير عبدًا لبريطانيا! كان السلطان المسكين لا يفقه شيئًا في السياسة، ولا يُحْسِن قراءة الواقع، ولا الاستفادة من التاريخ.
هكذا صارت هناك حكومتان في تركيا؛ الأولى في إسطنبول برئاسة السلطان (عُرِفَت في هذا الوقت بحكومة إسطنبول)، والثانية في أنقرة بقيادة مصطفى كمال باشا (حكومة أنقرة). هذا الوضع يُسمِّيه السياسيُّون «الحكومة الثنائية» Diarchy. يمكن للحكومة الثنائية أن تكون بالاتفاق؛ حيث يُدير كلُّ واحدٍ من الزعيمين أمرًا من الأمور؛ فيكونا متكاملين، ويمكن أن تكون بفرض الأمر الواقع دون اتِّفاق، فيكون الزعيمان متنازعَيْن[139]، والحكومة التي تكوَّنت في الدولة العثمانية في هذه الفترة كانت من النوع الأخير. هذه الحكومة الثنائية تختلف عن «حكومة الظلِّ» Shadow Cabinet، حيث تقوم المعارضة في حالة حكومة الظلِّ بتكوين وزارةٍ غير فاعلةٍ تكون مهمُّتها فحص ونقد أعمال الحكومة الشرعيَّة، وتكون جاهزةً لاستلام الحكم في حال استقالة أو إقالة الحكومة الشرعيَّة، وهذا النظام مشتهرٌ إلى الآن في بريطانيا[140]. في حالتنا هذه -حالة الحكومة الثنائية- نجد أن كلا الحكومتين «يمارس» الحكم بشكلٍ تنفيذيٍّ عملي، ومتعارض، وعلى مساحة الأرض نفسها، ومع أفراد الشعب أنفسهم!
من الطبيعي أن يحدث بين حكومتين من هذا النوع صراع، ولقد حدث بالفعل في حالتنا، وكانت البداية بمحاكمةٍ غيابيَّةٍ لمصطفى كمال أمر بها السلطان، وفيها صدر الحكم بإعدامه وعددٍ من مؤيِّديه، ثم تطوَّر الأمر إلى الصراع المسلح في شكل حربٍ أهليَّةٍ محدودة، وقد انتصر جيش الحركة الوطنية على جيش السلطان بسهولة، بل انضمَّ عددٌ كبيرٌ من رجال الجيش المهزوم إلى الحركة الوطنية، ممَّا دفع السلطان محمد السادس إلى حلِّ هذا الجيش في 25 يونيو 1920م، بعد شهرين ونصف من تكوينه[141].
كان مصطفى كمال ورجال الحركة الوطنية، يدعون إلى دولةٍ تقوم على النظام الجمهوري، المعتمد على مجلس شعب ودستور، في مقابل النظام الوراثي الذي عليه الدولة العثمانية، ولهذا كان الثوريُّون حريصين تمامًا على تطبيق خطوة البرلمان مبكرًا، كذلك كانوا حريصين على فعل ما يُرْضي الشعب، ليكون معهم في إقرار النظام الجمهوري، وكان أكثر ما يُرضي الشعب في هذه المرحلة هو إخراج المحتلِّين من تركيا، ولذلك لم يُوقِف مصطفى كمال باشا الحرب ضدَّ الفرنسيين في الجنوب على الرغم من التطوُّرات الكبيرة التي صحبت تأسيس البرلمان الجديد في أنقرة. حقَّق الثوريُّون الأتراك عدَّة انتصاراتٍ على الجيش الفرنسي في شهري مايو ويونيو 1920م[142]، ولكن في الفترة نفسها توسَّع الجيش اليوناني في غرب الأناضول حتى وصل إلى المناطق الشماليَّة منه[143].
كانت بريطانيا ترقب الموقف بقلقٍ شديد؛ فقد كانت تريد التدخل العسكري السريع لإنهاء المسألة قبل أن تتفاقم، فهي لم تتوقَّع أن تجد مقاومةً كهذه في الدولة العثمانية بعد سقوطها في الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك فكانت الحكومة الإنجليزيَّة تخشى من رأي العامَّة في بريطانيا الذين سئموا القتال والحروب بعد انقضاء السنوات الأربع المريرة للحرب العالميَّة[144]، ولهذا سعى الإنجليز لحلٍّ وسط، وهو دعم اليونانيين ليقوموا هم بالمهمَّة دون تدخُّلٍ مباشرٍ للجيش الإنجليزي، ممَّا دعا بعضهم إلى تسمية اليونان بوكيل بريطانيا في المنطقة Proxy Greece[145]! ردَّ مصطفى كمال على ذلك بالتواصل مع روسيا لتمدَّه بالسلاح والمال[146]. كانت روسيا البلشفية تريد تكوين «دولة عازلة» Buffer state بينها وبين الأملاك الإنجليزيَّة والفرنسيَّة في الشام واليونان[147]، ولهذا كان من مصلحتها أن تدعم كيان تركيا الجديد؛ فهي تعلم أن الأمر لو آل للسلطان الضعيف فإن ذلك سيعني سيطرة الإنجليز على تركيا كلِّها، وهذا سينقل حدود بريطانيا إلى روسيا مباشرة. -أيضًا- كان في التخطيط البلشفي الروسي ضمُّ جمهوريَّات أذربيچان، وأرمينيا، وچورچيا، في المستقبل، إلى كيانهم الواعد: الاتحاد السوفيتي، وقد قاموا بالفعل بضمِّ أذربيچان في 28 أبريل 1920م، أي بالتزامن مع تأسيس مجلس النواب التركي الجديد، وقيام حكومة أنقرة[148]، ولذلك كان من مصلحتهم التفاهم مع الحركة الوطنية التركية حول مستقبل أرمينيا وچورچيا، والحدود المستقبلية لروسيا. بالإضافة إلى ذلك كانت روسيا الجديدة تأخذ موقفًا عدائيًّا واضحًا من الغرب بشكلٍ عام، وكان من الواضح أن الوطنيِّين الأتراك لهم التوجُّه العدائي نفسه للغرب، فتحمَّس الروس لدعم الأتراك، وذلك من منطلق «عدوُّ عدوِّي صديقي»[149]! وافقت روسيا على دعم الحركة الوطنية إذن، وبدأ الجيش الوطني يأخذ شكلًا قويًّا لافتًا.
كانت الرؤية غير واضحةٍ عند كثيرٍ من أفراد الشعب، وكانوا ينتظرون حدثًا يُرجِّح إحدى الكفتين؛ السلطان أو الحركة الوطنية، وقد أوقع الإنجليز أنفسهم والسلطانَ في خطأ كبيرٍ جعل كفَّة الحركة الوطنية ترجح بشدَّة، وكان هذا الخطأ هو توقيع معاهدة سيڤر، والتي أوقع فيها الحلفاء ظلمًا كبيرًا على الدولة العثمانيَّة، ووافق عليه الوفد العثماني الممثِّل للحكومة[150]، فاستغلَّ الثوريُّون الحدث لكشف الضعف الشديد للسلطان وحكومته[151]!
معاهدة سيڤر (1920م):
وُقِّعت هذه المعاهدة في ضاحية سيڤر Sèvres القريبة من باريس بفرنسا[152] في 10 أغسطس 1920م[153]، وكانت بحضور ممثِّلين عن الحلفاء وأعوانهم (بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان)، بالإضافة إلى الدولة العثمانية[154]. لم يكتفِ الحلفاء في هذه المعاهدة بسلخ الولايات العربيَّة من الدولة العثمانيَّة، ولكن قاموا بتقطيع الأناضول نفسه[155] (خريطة رقم 42)، ووضعوا قيودًا على الدولة تمنعها تمامًا من القيام لاحقًا. كانت المعاهدة في الواقع غير منطقيَّة، وكان قبولها يعني الفناء الكامل للدولة العثمانيَّة دون وريث؛ لا من الأتراك، ولا من غيرهم! كانت المعاهدة المجحفة مكوَّنة من أربعمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثين بندًا[156]، ولكن يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. توضع المضايق تحت إدارةٍ دوليَّة، وغير مسموحٍ لتركيا بمنع أيِّ سفينةٍ تحت أيِّ علمٍ من الدخول للمضايق، ولا يملك تغيير قواعد دخول المضايق إلا «عصبة الأمم» League of Nations[157]. (كان الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى قد كوَّنوا في 1920 تحالفًا عالميًّا عُرِف بعصبة الأمم، بدعوة ودعم من الرئيس الأميركي وودرو ولسون Woodrow Wilson[158]، وهذا يعني أن دخول المضايق سيكون تحت تصرُّف الحلفاء المهيمنين على عصبة الأمم في الواقع)!
2. تحويل عددٍ من موانئ الدولة العثمانيَّة إلى مناطق حرَّة free zones، وهذا يشمل إسطنبول (من سان ستيفانو San Stefano إلى ضولمابهسي Dolmabahçe)، وإزمير (على بحر إيجة)، وحيدر باشا Haidar-Pasha (على البوسفور)، والإسكندرونة، وحيفا (على البحر المتوسط)، والبصرة (على الخليج العربي)، وطرابزون، وباطوم (على البحر الأسود)[159]. لن تكون إدارة هذه المناطق في يد الدولة العثمانية؛ إنما ستكون في يد هيئةٍ دوليَّةٍ تُختار فيما بعد[160]! (هذا احتلالٌ مباشرٌ للعاصمة ولعدَّة مدنٍ حيويَّةٍ على كلِّ البحار التي تطلُّ عليها الدولة العثمانية، بالإضافة إلى الخسارة الاقتصاديَّة الفادحة؛ لأن رءوس المال التجاريَّة الكبرى كلَّها في يد الحلفاء، وهي دولٌ صناعيَّةٌ كبرى ذات إنتاجٍ واسع، وستكون التجارة في هذه الموانئ بلا جمارك تقريبًا، فلن تستفيد منها إلا الشركات الغربيَّة العملاقة، وستُحْرَم الدولة العثمانية من أحد أهمِّ موارد ثروتها في ذلك الوقت، وهو التجارة الوسيطة).
3. تُدمَّر كلُّ القلاع والحصون في منطقة المضايق كلِّها؛ ويشمل ذلك الدردنيل، والبوسفور، وبحر مرمرة، والجزر المحيطة في بحر إيجة[161].
4. تقع فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي[162].
5. ستكون بريطانيا مسئولةً عن تطبيق الإعلان الذي أطلقه بلفور لليهود بإقامة وطنٍ قوميٍّ لليهود في فلسطين[163]! (لم يكن هذا استنباطًا منَّا نتيجة وقوع الانتداب الإنجليزي على فلسطين، ولكنَّه كان بندًا صريحًا منفصلًا في المعاهدة التي وقَّع عليها الوفد العثماني، وهو البند الخامس والتسعين، وسنرى بعد ذلك في سياق الأحداث أنه ستُلغَى معاهدة سيڤر، ومع ذلك علَّق بلفور على الإلغاء بقوله: مهما حدث لمعاهدة سيڤر سيظلُّ الوعد قائمًا لليهود[164]! هكذا كان حرص بريطانيا على تأسيس وطنٍ لليهود في فلسطين)!
6. تقع العراق تحت الانتداب الإنجليزي[165].
7. تقع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي[166].
8. ستكون الحجاز إمارةً مستقلَّةً (تحت حكم الأشراف)، وكذلك اليمن (تحت حكم الزيديين)، وعسير (تحت حكم السعوديين)، والكويت (تحت حكم آل الصباح) [167]. (بهذا تكون بريطانيا قد غدرت بالشريف حسين الذي ساعدها بثورته العربيَّة ضدَّ الدولة العثمانيَّة، في الوقت الذي حرصت فيه على الوفاء بوعدها لليهود مهما كلفها الأمر!)
9. ستصل حدود أرمينيا إلى غرب طرابزون، بمعنى أن طرابزون ستكون داخلةً في الدولة الأرمينيَّة! -أيضًا- تشمل الدولة الأرمينيَّة الجديدة مدينتي إرضروم، وڤان. (هذه الحدود تعني دخول معظم الشمال الشرقي للأناضول داخل أرمينيا، وهذه كانت توصية الرئيس الأميركي وودرو ولسون، ولهذا تُعْرَف هذه الحدود بأرمينَّية ولسون Wilsonian Armenia[168]، ومن المعروف أنها لم تُطَبَّق قط على وجه الحقيقة[169]، وكان الرئيس الأميركي يرغب في هذه الحدود الواسعة لكي يضع عليها الانتداب الأميركي، ولكن الكونجرس الأميركي رفض هذا الانتداب[170]!).
10. ستُخلَّق دولة جديدة تحت اسم كردستان، في جنوب شرق الأناضول، وشمال العراق، وستُقرَّر حدودها بالرجوع إلى أهالي المنطقة، على أن تكون الموصل داخلة في حدود هذه الدولة الجديدة[171]! (عندما تفشل بريطانيا لاحقًا في تأسيس هذه الدولة الكرديَّة، ستقوم بضم الموصل إلى العراق، الذي يقع تحت احتلالهم، وذلك للاستفادة بآبار البترول الواعدة في الموصل[172])!
11. ستُضَمُّ منطقة تراقيا الشرقية حتى شطلجة Çatalca إلى اليونان[173]، وهذا يعني ضياع معظم تراقيا الشرقية بما فيها إدرنة[174]).
12. ستُعطى جزر إمبروس وتيندوس لليونان[175]. (هذه الجزر تسيطر على الملاحة تمامًا في المضايق).
13. ستُعطى جزر الدوديكانيز ورودس إلى إيطاليا[176].
14. ستكون هناك مناطق نفوذ أجنبي في الأناضول[177]؛ حيث ستكون هذه المناطق -على الرغم من كونها تركيَّة- تحت السيادة العسكريَّة والقانونيَّة للدولة الأجنبيَّة، وهذه المناطق هي:
a. منطقة نفوذ فرنسي: تشمل أجزاء كبيرة من منطقة قيليقية، وجنوب شرق الأناضول، وتشمل عدَّة مدنٍ مهمَّة؛ مثل عنتاب، وأورفا، وماردين، وأضنة[178]، بل تصل إلى سيواس، وتوقات[179]، في وسط الأناضول.
b. منطقة نفوذ يوناني: وهذه منطقة واسعة في غرب الأناضول مركزها إزمير، وسيكون لها وضعٌ خاصٌّ حدَّدته المعاهدة؛ وهو قيام اليونان بسيادة المدينة، وإنشاء برلمان، وإقامة قاعدةٍ عسكريَّةٍ لجنودها، ويظلُّ هذا الوضع لمدَّة خمس سنوات، وبعدها يُجْرَى استفتاء Plebiscite لجمهور إزمير، الذي سيختار ضمَّ المدينة نهائيًّا إلى اليونان أو الدولة العثمانية[180]. (لا بُدَّ أن يؤخذ هذا البند في ضوء معرفة أن نسبة السكان اليونانيين إلى الأتراك في إزمير كانت سبعة إلى خمسة لصالح اليونانيين قبل غزو اليونان عام 1919م[181]، وفوق هذا فقد مرَّ بنا قيام الجيش اليوناني بمذابح في المدينة عند احتلالها، وهذا أدَّى إلى تناقص الأتراك بشكلٍ أكبر؛ إمَّا عن طريق القتل أو الهجرة هربًا من الموت، ولذا فمن المتوقَّع أن تقلَّ نسبتهم جدًّا في أثناء السنوات الخمس التي سيحكمها اليونانيون طبقًا للمعاهدة، ممَّا يعني أن الاستفتاء سيقود حتمًا لضمِّ إزمير وما حولها لليونان).
c. منطقة نفوذ إيطالي: منطقة واسعة في جنوب وسط الأناضول، تشمل عدَّة مدنٍ كبرى مثل أنطاليا، وقونية، وأَفْيُون، وأيدن[182].
15. ستوضع مراقبةٌ ماليَّة على الحكومة العثمانيَّة، مع وجوب موافقة الحلفاء على الميزانيَّة الماليَّة، ومراقبة ووضع القوانين الماليَّة[183].
16. ستعاد «مؤسسة الدَيْنِ العام العثماني» Ottoman Public Debt Administration (OPDA) إلى العمل، وستكون تحت رعاية بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا[184]. (هذه مؤسَّسة مكلفة برقابة الميزانيَّة العثمانيَّة والمشروعات، وكانت قد أُسِّست عام 1881، زمن السلطان عبد الحميد الثاني، لإجبار الدولة العثمانيَّة على توجيه جانبٍ كبيرٍ من دخلها لسداد الديون المتراكمة عليها، وكانت تُدار بعددٍ كبيرٍ من الأجانب؛ من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وقد رُحِّل موظفو الحلفاء منها أثناء الحرب العالمية، ثم الآن بعد هزيمة العثمانيِّين في الحرب حدث العكس؛ فقد رُحِّل الموظفون الألمان والنمساويون، وستُعيد معاهدة سيڤر الموظفين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين[185]).
17. ستعود الامتيازات التجاريَّة التي أعطتها الدولة العثمانية قبل ذلك إلى الدول الأوروبِّيَّة[186]. (كانت هذه الامتيازات قد أُلغيت عام 1914 عند دخول الدولة العثمانية في الحرب[187])، وستُمدُّ هذه الامتيازات إلى دولٍ أوروبِّيَّةٍ جديدة؛ كالبرتغال، ورومانيا، وكذلك إلى أرمينيا[188].
18. سيُعْفَى تجار دول الحلفاء من أيِّ ضرائب نقل أو مرور داخل الدولة العثمانيَّة[189]!
19. لا يحقُّ للدولة العثمانية القيام بأيِّ تغييرٍ في نظام الضرائب، أو الجمارك، أو القروض الداخليَّة أو الخارجيَّة، أو التصدير والاستيراد، إلَّا بالرجوع لدول الحلفاء[190]!
20. على الدولة العثمانية أن تتخلص من أيِّ ممتلكاتٍ خاصَّةٍ بمواطنين من ألمانيا، أو النمسا، أو المجر، أو بلغاريا (دول المركز المنهزمة في الحرب)، وذلك في غضون ستَّة أشهر، وتحت رعاية الحلفاء[191].
21. سيُحَلُّ الجيش العثماني[192] (لن يكون للدولة جيش!)، ولن يُسمح للدولة العثمانيَّة إلا بقوَّة الشرطة المسلحة بالسلاح الخفيف فقط، على ألَّا تزيد عن خمسين ألفٍ وسبعمائة جندي[193]!
22. لا يمكن للبحريَّة العثمانيَّة أن تحتفظ بأكثر من سبع بوارج، وستَّة طوربيدات، ولا تُستعمل هذه السفن إلا في أمور الشرطة والصيد فقط[194]، وتُفكَّك السفن الزائدة عن هذا الحد، ولا يحقُّ للدولة العثمانية بيع الأسلحة المستخرجة من السفن المدمَّرة إلى دولٍ أجنبيَّة، بل ينبغي تدميرها أو استخدامها في صناعاتٍ مدنيَّة، ولا يحقُّ للدولة العثمانية تصنيع أو امتلاك غوَّاصات[195]!
23. لا يحقُّ للدولة العثمانية امتلاك قوَّاتٍ جوِّيَّة[196]! ولا أن تقوم بتصنيع طائرات[197]!
24. ستقوم الدولة العثمانية بتقديم تعويضاتٍ لليونانيين والأرمن[198].
25. تُشكَّل لجانٌ من الحلفاء للتحقيق في جرائم القتل والتهجير (الخاصَّة بالأرمن أساسًا، وكذلك باليونانيين)، ويكون لها حقُّ القضاء على الذين تدينهم، بما في ذلك النفي ومصادرة الأموال[199].
26. أيُّ مخالفةٍ لشروط المعاهدة سيكون عقابها طرد الحكومة العثمانية من إسطنبول[200]!!
هذه -بإيجاز- هي معاهدة سيڤر!
وَصَفَ المؤرِّخ الأميركي ﭼون دون John P. Dunn هذه المعاهدة بأنها شديدة القسوة[201]، أمَّا أكثر المؤرِّخين فلا يتردَّدون في وصفها بأنها مُذِلَّة Humiliating[202][203][204]! يقول المؤرِّخ الهندي الكبير ب. ڤ. راو B. V. Rao في كتابه عن تاريخ آسيا: «أدَّت هزيمة الإمبراطوريَّة العثمانيَّة على يد الحلفاء إلى معاهدة سيڤر المذلَّة. سلَّم السلطان العثماني نفسه بخنوعٍ للحلفاء. أدَّى التسليم الذليل للسلطان إلى غضب الشعب. لم يكن لهم طاقةٌ بتحمِّل هذا الذلِّ أطول من ذلك»[205]!
الحقُّ إن أقلَّ ما يُقال عن هذه المعاهدة أنها «مجنونة»! لا يُعقل أن يجلس السياسيُّون على طاولة مفاوضاتٍ ثم يخرجون بهذا الهراء، وأعجب من ذلك هو توقيع الوفد العثماني على المعاهدة[206]! من المؤكَّد أن هذه ليست مسئوليَّة «الموظفين» الذين سافروا إلى سيڤر بفرنسا ليوقِّعوا على المعاهدة، ولكنها مسئوليَّة السلطان والحكومة؛ لأن تنازلاتٍ خطرةً كهذه لن تكون إلا بالاتفاق مع الحكومة المركزيَّة. إن العلماء الذين درسوا المعاهدات المختلفة التي عُقِدَت بعد الحرب العالمية الأولى يُجزمون أن الشروط التي فُرِضت على الدولة العثمانية في هذه المعاهدة أشدُّ وطأةً من تلك التي فُرِضت على ألمانيا ذاتها[207][208][209][210]! كان من الواضح أن إسلاميَّة الدولة العثمانيَّة كانت مثيرةً لأحقاد الأوروبِّيِّين، فخرجت المعاهدة على هذه الصورة الحاقدة غير العقلانيَّة. ساعد -أيضًا- على كتابة المعاهدة على هذا النحو المذري الضعفُ الشديد الذي أبداه السلطان محمد السادس أمام الإنجليز، كذلك قيامه -مدفوعًا بالإنجليز- بحلِّ البرلمان، فصار وحيدًا -دون دعمٍ من شعبه- في مواجهة قوى العالم. من تعاسة الدول حقًّا أن يحرص زعماؤها على البقاء في السلطة مهما كانت الأثمان، وكان السلطان العثماني بقبوله لهذه المعاهدة المشينة كلاعب الشطرنج الذي يُضَحِّي بجيشه كلِّه من أجل حياة المـَلِك!
لا ينبغي لمثل هذه الخرافات أن تُقْبَل!
حرب الاستقلال التركية:
أشعلت معاهدة سيڤر روح الوطنيَّة عند الأتراك، وخاصَّةً المسلمين منهم، وشعروا أن العالم يتكالب عليهم، فكان ردُّ الفعل كبيرًا عند الشعب، ولو يعلم الحلفاء هذه النتيجة ما فرضوا هذه الشروط المستفزَّة على الدولة العثمانية.
اجتمع مجلس النوَّاب الجديد في أنقرة، بتاريخ 19 أغسطس 1920م -بعد المعاهدة بتسعة أيام فقط- وأعلنوا رفض المعاهدة جملةً وتفصيلًا[211]، بل أصدروا مرسومًا يطالب بمحاكمة مجلس السلطان، وأولئك الذين أوصوا بالموافقة على معاهدة سيڤر، وأولئك الذين وقَّعوا عليها، وذلك بتهمة الخيانة للوطن[212]. كان هذا ردًّا من مصطفى كمال على قرار إعدامه السابق، ففي غضون ثلاثة شهور صار القرار عكسيًّا، وها هو ومجلس النوَّاب يطالبون بمحاكمة السلطان وحزبه بتهمة الخيانة، وهي تهمةٌ قد يكون عقابها الإعدام! بل ذكرت بعض المصادر أن مجلس النوَّاب أوصى بالفعل بإعدام الموقِّعين على المعاهدة[213]. تُعتبر معاهدة سيڤر هي الضربة القاضية الأخيرة لحكومة السلطان في إسطنبول، وبعدها صار المواطن العادي في صفِّ حكومة أنقرة[214]. كان هذا دعمًا قويًّا للميثاق الوطني الذي يُعطي الدولة التركيَّة حدودًا أكبر بكثيرٍ من تلك التي فرضتها معاهدة سيڤر، والأهمُّ من ذلك أنه يُعطي الدولة استقلالًا وحرِّيَّة، على عكس اتفاقية سيڤر التي تُكَبِّل الدولة بعشرات القيود، وتحرمها -الآن ومستقبلًا- من أيِّ فرصة قوَّة، أو مجرَّد قيام.
لم يكتفِ المجلس الجديد «بشجب» المعاهدة؛ إنما أخذ القرار الجريء بالبدء في «فرض» الحدود التي يرونها لدولتهم على القوى الأجنبيَّة المحتلَّة بالقوَّة. سيبدأ المجلس، والحركة الوطنية، والجيش الوطني، وكثيرٌ من أبناء الشعب، من بعد هذه المعاهدة، في حربٍ شرسةٍ ضدَّ عدَّة قوى عالميَّة، في آنٍ واحد! هذا ما عُرِف «بحرب الاستقلال التركية» Turkish War of Independence[215]، وهي الحرب التي ستكون على جبهاتٍ ثلاث؛ الأولى ضدَّ أرمينيا -المدعومة بفرنسا، وبريطانيا- في شرق الأناضول، والثانية ضدَّ فرنسا في جنوب الأناضول، والثالثة ضدَّ اليونان -المدعومة ببريطانيا- في غرب الأناضول وتراقيا الشرقيَّة! (خريطة رقم 43) إنها -بحسابات الورق- معارك مستحيلة، ولكنَّها على أرض الواقع كانت غير ذلك!
يقول المؤرِّخ الأميركي سين ماك ميكين Sean McMeekin: «لم تكن هناك دعايةٌ لتجنيد الشعب في جيش مصطفى كمال باشا أفضل من معاهدة سيڤر»[216]!
حقًّا، رُبَّ ضارَّةٍ نافعة!
أولًا: الحرب التركية الأرمينية:
بدأ الأتراك القوميُّون في الإعداد لفرض حدودهم الشرقيَّة وقتال الأرمن في منتصف يونيو 1920[217]، أي قبل توقيع معاهدة سيڤر بشهرين تقريبًا، ولذلك فبمجرَّد إعلان المعاهدة كانت القوَّات التركيَّة في جاهزيَّةٍ أعلى بكثيرٍ من القوَّات الأرمينيَّة، ومِنْ ثَمَّ بدأت عمليَّاتها العسكريَّة في 13 سبتمبر 1920، وحقَّقت انتصارًا سريعًا على فرقةٍ أرمينيَّة، وتمكنت من احتلال قريةٍ صغيرة اسمها بينيك Penek (على بعد مائةٍ وعشرين كيلو مترًا تقريبًا شرق إرضروم، وهي على الحدود التركيَّة الأرمينيَّة آنذاك). عندما وجد مصطفى كمال أن ردَّ الفعل الأرمني ضعيف، وكذلك ردَّ فعل الحلفاء، أصدر أمره لقوَّاته بهجومٍ شاملٍ على الجيش الأرمني. أظهر الجانب التركي قوَّةً عظيمةً بقيادة كاظم باشا، وحقَّق انتصاراتٍ متكرِّرة[218].
لم يكتفِ الجيش التركي بصدِّ الأرمن عن شرق حدود تركيا بل اجتاز الحدود الأرمينيَّة آنذاك[219]، وضمَّ قارص، وأردهان[220]. هاتان المدينتان خارج الحدود التركيَّة في الميثاق الوطني. في 18 نوفمبر استسلمت أرمينيا، وطلبت وقف إطلاق النار[221]. هكذا في أقلَّ من شهرين حقَّق الأتراك القوميُّون حدودهم الشرقيَّة وزيادة! لم يتمكَّن الإنجليز من إرسال دعمٍ عسكريٍّ للأرمن لأن الرأي العام في الشارع البريطاني كان ضدَّ الحرب في الأناضول، وضدَّ الحرب بشكلٍ عام بعد كوارث الحرب العالمية الأولى.
أدركت أرمينيا أن الحلفاء لن يُرسلوا دعمًا عسكريًّا فاضطرَّت إلى طلب الدعم من روسيا، التي قامت في 29 نوفمبر باقتحام أرمينيا، وضمها لها[222]. لم يكن هذا الاحتلال الروسي مزعجًا للحركة الوطنية التركيَّة؛ لأنها كانت متواصلةً مع الروس كما أسلفنا، ويتَّفقان سويًّا على الوقوف أمام العدوِّ المشترك، وهو الغرب، ولذا قبلت الحركة الوطنية بعقد اتفاقيَّة حدود مع حكومة أرمينيا (التابعة الآن لروسيا بعد احتلالها) في مدينة ألكسندروبول Alexandropol يوم 2 ديسمبر 1920م لترسيم الحدود بين الطرفين، وفيها أقرَّت أرمينيا بدخول قارص وأردهان في حدود تركيا، بل أكثر من ذلك قبلت أرمينيا بحلِّ جيشها، في نظير أن يُقَدِّم لهم الأتراك المعونة العسكريَّة وقت الحاجة، وقبلت كذلك بالموافقة على أن يستخدم الأتراك أرضهم للمناورات العسكريَّة إذا احتاج الأتراك إلى ذلك[223]! هكذا فرضت القوَّة التركيَّة قانونها بعيدًا عن طاولة المفاوضات الغربيَّة المجحفة! كانت هذه الاتفاقيَّة بعلم الروس، ومع ذلك حرصت الحركة الوطنية التركيَّة على توثيق اعتراف روسيا بالوضع الجديد، ولذا عَقَدَت معاهدةً جديدةً مع الروس في موسكو في 16 مارس 1921م، وفيها اعترفت روسيا بملكيَّة تركيا للمدن التي سيطرت عليها في حربها الأخيرة مع أرمينيا[224][225].
ثانيًا: الحرب التركية الفرنسية:
كانت الحرب مستمرَّةً على هذه الجبهة -كما مرَّ بنا- منذ أوَّل سنة 1920م بين الحركة الوطنية من جهة، وفرنسا ومعاونيها من الأرمن من جهةٍ أخرى، ولكنَّها كانت على الأغلب في صورة حروب العصابات، التي تعتمد على الكرِّ والفر، وليس على المواجهات المفتوحة. بعد سجالاتٍ كثيرةٍ عُقِد مؤتمر سلام بين الطرفين في لندن في 9 مارس 1921م، وفيه وعدت فرنسا بسحبٍ جزئيٍّ لقوَّاتها من الأناضول تمهيدًا لعقد معاهدةٍ أخرى لترسيم الحدود بين تركيا وسوريا (الواقعة آنذاك تحت الاحتلال الفرنسي)[226]. في المؤتمر نفسه -وبعد يومين من الاتِّفاق مع الفرنسيين- تمكن الأتراك من عقد اتفاقيَّة سلامٍ أخرى مع إيطاليا، وبذلك تجنَّبت الدخول في صدامٍ مع هذه الدولة القويَّة، وكان الصدام في الحقيقة متوقَّعًا لأنه من المفترض أن تبحث إيطاليا عن المستعمرات التي أعطتها لها معاهدة سيڤر منذ شهور في جنوب الأناضول. السرُّ في تغيُّر موقف فرنسا وإيطاليا إلى السكون والرضوخ للحركة الوطنية التركيَّة يعود إلى قناعة الدولتين بأن بريطانيا تدعم اليونان بقوَّة لتكون حليفًا لها في الأناضول، ورأي الفرنسيون والإيطاليون أن إضعاف الأتراك ليس في مصلحتهم؛ لأنهم لا يريدون قوَّةً كبيرةً لليونانيين حلفاء الإنجليز في الأناضول[227].
كان من الواضح أن التحالف الذي كان بين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين في الحرب العالمية الأولى هو تحالف مصلحة بحتة، وعندما انتهت هذه المصلحة عاد التنافس القديم بينهم إلى حالته الأولى. استفاد السياسيُّون الأتراك الجدد من هذا التعارض في المصالح. -أيضًا- لا بُدَّ من الإشارة إلى أنه لولا صلابة الموقف التركي في الحرب مع الأرمن والفرنسيين ما كان لفرنسا أو إيطاليا إن يُراهنا على تركيا، ولو جلس المفاوضون الأتراك في مؤتمر لندن بالروح الانهزاميَّة نفسها التي جلس بها المفاوضون العثمانيون في سيڤر ما حقَّقوا شيئًا!
كان عقد المؤتمر في لندن إشارةً إلى قبول الإنجليز -مضطرِّين في الحقيقة تحت ضغط الأمر الواقع- بالكيان الوطني التركي الجديد، ومع ذلك لم يكن الإنجليز راضين قط عن قبول الفرنسيين بسحب جيوشهم من الأناضول؛ لأن هذا سيُخفِّف الضغط على الأتراك، فيتمكنون من قتال اليونانيين، ولم يكونوا راضين كذلك عن السكون الإيطالي، ولذلك لم يتردَّد رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد لويد چورچ David Lloyd George -بعد أن رأى التراجع الفرنسي والإيطالي- من أن يُعلن عن تشجيعه السافر لليونانيين بالحرب ضدَّ حركة مصطفى كمال الوطنيَّة[228]! كان الإنجليز يريدون قتال الأتراك، ولكن فقط عن طريق وكلائهم في الأناضول -اليونانيين- احترامًا لرأي الشارع البريطاني الذي سئم القتال!
ثالثًا: الحرب التركية اليونانية:
كانت هذه أشدَّ الحروب، لكون الجيش اليوناني أقوى بكثيرٍ من الجيش الأرمني، وهو مدعومٌ بقوَّةٍ من بريطانيا، ويمتلك اليونانيون حماسةً كبيرةً لتوسيع حدودهم بشكلٍ دائم، على عكس الفرنسيين في الجنوب الذين يريدون فقط تأمين مستعمرتهم في سوريا، أو توسيعها قليلًا على حساب الأناضول. هذا جعل حرب اليونان أشدَّ من حرب أرمينيا وفرنسا. يبدو أنه لهذه الأسباب أجَّل مصطفى كمال حرب اليونان إلى ما بعد الانتهاء من ملفَّي أرمينيا في الشرق، وفرنسا في الجنوب. -أيضًا- استغلَّ مصطفى كمال هذا الوقت في تكوين جيشٍ نظاميٍّ ثابت، وهو أوَّل جيشٍ للدولة التركيَّة الجديدة، وكان مجهَّزًا بأسلحةٍ روسيَّةٍ متطوِّرة. كانت روسيا تأخذ على عاتقها دعم تركيا -على الرغم من كراهيَّتها التاريخيَّة للأتراك- وقد وصل دعمها للحركة الوطنية في عام 1920م إلى إمدادها ليس فقط بالسلاح، ولكن بالمال كذلك؛ لكي تتمكن من شراء السلاح من مصادر أخرى، ولدعم تموين الجيش في الحرب المرتقبة ضدَّ اليونان، ولقد بلغت المعونة الروسيَّة في عام 1920م فقط إلى مليون روبيَّة ذهبيَّة، بالإضافة إلى أكثر من مائتي كيلو جرام من الذهب، وستستمر الإعانة في السنوات التالية[229]! لم تكن هذه المعونة مشروطة؛ إنما كانت تُحقِّق الفائدة لروسيا عن طريق تقليص نفوذ الغرب في المنطقة. -أيضًا- ساعدت الظروف الحركة التركيَّة بشكلٍ عجيب؛ حيث حدث أن تغيَّرت القيادة فجأة في اليونان، وعاد للحكم الملك كونستانتين الأول Constantine I، الذي كان مؤيِّدًا للألمان، وقد كرهه الفرنسيون والإيطاليون بشدَّة، ممَّا دفعهما إلى دعم الأتراك بشكلٍ مفاجئٍ وعجيب؛ إذ تركت فرنسا سلاحها الثقيل في جنوب الأناضول للجيش التركي الجديد، أمَّا إيطاليا فساعدت على المستوى الاستخباراتي[230]! هكذا تحوَّل أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم! كانت بريطانيا هي الأخرى ترفض الملك كونستانتين لكنَّها كانت مضطرَّةً إلى دعم اليونان للقضاء على تركيا.
هكذا بدأت الحركة الوطنية التركيَّة بقيادة مصطفى كمال باشا حربها ضدَّ اليونانيين، وفي ظلِّ غيابٍ كامل للسلطان ووزرائه عن الصورة!
كانت أولى المعارك مع اليونانيين بالقرب من مدينة إينونو İnönü بالقرب من مدينة إسكيشهير Eskişehir[231]، وهذه الأخيرة تقع على بعد مائتي كيلو متر غرب أنقرة. كان جيش الحركة الوطنية بقيادة اللواء مصطفى عصمت باشا، وهو عسكريٌّ متميِّزٌ ترك إسطنبول بعد احتلال الإنجليز لها بثلاثة أيَّام، والتحق بالحركة الوطنية في أنقرة في أبريل 1920م[232]. على الرغم من أن هذا القائد القدير كان شابًّا في السادسة والثلاثين من عمره فإنه صار أهمَّ المستشارين العسكريِّين للحركة الوطنية، وتولَّى من فوره قيادة الجيش التركي في الجبهة الغربيَّة، أي ضدَّ اليونان[233]. حقَّق مصطفى عصمت باشا نصرًا كبيرًا في موقعة إينونو في الفترة بين 9 و11 يناير 1921م، ثم أعاد النصر على اليونانيين عند بلدة إينونو مرَّةً ثانية في 26-31 مارس من السنة نفسها[234]. هذان الانتصاران أكسباه اسم البلدة التي تمَّ عندها النصر، فصار اسمه الأشهر هو «عصمت إينونو» İsmet İnönü[235]! هذا هو السياسي الشهير، الذي سيُصبح الرئيس الثاني لجمهوريَّة تركيا في الفترة من عام 1938 إلى عام 1950[236].
على الرغم من هذا الانتصارات الأولى فإن الجيش التركي بقيادة عصمت إينونو تعرَّض لهزيمة من الجيش اليوناني بقيادة ملك اليونان كونستانتين الأول Constantine I، في الفترة بين 10 و23 يوليو 1921م، ممَّا أدَّى إلى سقوط كوتاهية Kutahya في يد الجيش اليوناني، وكاد الجيش التركي يقع في فخ خطر لولا انسحاب عصمت إينونو بالجيش شمالًا إلى ساحل نهر سقاريا Sakarya River شمال غرب الأناضول[237].
كان الموقف حرجًا؛ إذ صار الطريق مفتوحًا إلى أنقرة! في 4 أغسطس 1921 عيَّن مجلس النوَّاب مصطفى كمال باشا رئيسًا للأركان، بالإضافة إلى كونه رئيسًا للبرلمان[238]. في 10 أغسطس بدأ الملك اليوناني في التحرُّك بجيشه صوب سقاريا لملاقاة جيش عصمت إينونو[239]، وتحرَّك مصطفى كمال في الوقت نفسه بجيش من أنقرة لمساعدة جيش إينونو[240]. كان مجموع الجيش التركي تسعين ألف جندي، بينما كان جيش اليونان مائة ألف جندي، ولكن كان تسليح الجيش اليوناني أفضل[241]. كان الجيش اليوناني يملك ستمائة وعشرة مدافع، وأربعة آلاف رشاشًا آليًّا، وعشرين طائرة، في مقابل أربعمائة مدفع، وسبعمائة رشاشًا آليًّا، وأربع طائرات للأتراك. هذه فروقات حاسمة[242]! على ضفاف نهر سقاريا دارت موقعة حاسمة بين الجيشين في الفترة من 23 أغسطس إلى 13 سبتمبر 1921، وفي النهاية، وبعد قتالٍ ضارٍ، وعلى الرغم من فارق التسليح، تمكَّن الجيش التركي من تحقيق النصر المجيد[243]. كان عدد القتلى في الطرفين متقاربًا، ويدور حول أربعة آلاف من كلِّ فريق، ومع ذلك لم يستطع الجيش اليوناني إكمال المعركة واضطرَّ إلى الانسحاب[244]، دمَّر اليونانيون أثناء انسحابهم السككَ الحديديَّة، وأحرقوا كلَّ القرى التي أخلوها بعد ترحيل السكان اليونانيين معهم أثناء الانسحاب[245].
كانت معركة سقاريا نقطة تحوُّلٍ في مسار الحرب التركية اليونانية، بل كانت نقطة تحوُّلٍ في التاريخ التركي؛ فبعد هذه الموقعة لم يأخذ الجيش اليوناني زمام المبادرة، وكان من انسحاب إلى انسحاب[246]، و-أيضًا- بدأ الشعب التركي يتعامل مع الحركة الوطنية بمنظورٍ آخر؛ حيث صاروا الممثِّلين الحقيقيِّين للأمَّة التركيَّة، وانزوى دور السلطان والعثمانيِّين بشكلٍ كبير؛ حيث كانوا محصورين بلا أيِّ مهمَّةٍ في إسطنبول المحتلَّة. حصل مصطفى كمال على لقب «غازي» بعد هذه الموقعة المفصليَّة[247]. يقول المؤرِّخ الأميركي ماك ميكين: «كانت سقاريا انتصارًا تاريخيًّا تركيًّا، أوقف التقدُّم اليوناني، وأحيا الحركة الوطنية التركيَّة»[248]!
معاهدتا قارص وأنقرة مع روسيا وفرنسا (أكتوبر 1921م):
حققت الحركة الوطنية نجاحًا جديدًا لافتًا في الشهر التالي مباشرة لمعركة سقاريا، وهو عقد معاهدتين مهمَّتين؛ الأولى مع روسيا، والثانية مع فرنسا.
كانت المعاهدة الأولى في قارص في 13 أكتوبر 1921م[249]، وكانت مع روسيا، بحضور ممثِّلين عن جمهوريَّات أرمينيا، وچورچيا، وأذربيچان[250]، وفيها رُسِّمت حدود المنطقة الشرقيَّة مع كلٍّ من أرمينيا وچورچيا[251]، وترجع أهميَّة هذه المعاهدة أنها كانت بموافقةٍ رسميَّةٍ موثَّقةٍ من روسيا التي تحتلُّ أرمينيا وچورچيا، وأذربيچان الآن.
أمَّا المعاهدة الثانية فكانت مع فرنسا؛ وفيها فُعِّل التنازل الذي أقرَّت به فرنسا في لندن في معاهدة 9 مارس 1921م. عُقِدَت المعاهدة الجديدة في أنقرة في 20 أكتوبر 1921م[252]، وفيها أقرَّت فرنسا بتسليم تركيا كلَّ إقليم قليقية، ويشمل مدن الأناضول الجنوبيَّة؛ أضنة، ومرعش، وعنتاب، وأورفا، وماردين، ونصيبين، وجزيرة ابن عمر، وبالتالي وقف أيِّ أعمالٍ عدائيَّةٍ بين الطرفين[253]. في الواقع كان نصرًا تركيًّا متميِّزًا.
لم تكن الأهميَّة الكبرى في هاتين المعاهدتين تقع فقط في إقرار الانتصارات التركيَّة، أو في اكتساب أراضٍ جديدة، أو في تفريغ جيش الحركة الوطنية لحرب اليونان بعد تسكين الجبهتين الشرقيَّة والجنوبيَّة، على الرغم من الأهميَّة القصوى لكلِّ ما سبق، ولكن الأهميَّة الأكبر -في رأيي- كانت في الأساس في أمرين عظيمين؛ الأوَّل هو اعتراف اثنين من القوى العظمى العالميَّة -روسيا، وفرنسا- بالحركة الوطنية التركية، وهذا لم يُكْسِبها تواجدًّا في الساحة العالميَّة فقط، ولكن رسوخًا واضحًا في المجتمع التركي؛ والثاني هو تحقيق هاتين المعاهدتين للحدود التي أعلنتها الحركة الوطنية في الميثاق الوطني، ممَّا يُثبت وضوحَ رؤيةٍ كبير عند مخططي الميثاق، وعزيمة صارمة في تنفيذه بالقوَّة على أرض الواقع. هذه في الواقع عوامل نجاح تؤكد واقعيَّة الحركة الوطنية، وبُعْد نظرها، عندما صاغت بنود هذا الميثاق الوطني.
تحرير إزمير، وطرد اليونانيين من الأناضول (1922م):
بعد موقعة سقاريا أخذ الجيش اليوناني منهجًا دفاعيًّا، وهذا أثر سلبًا على معنويَّاته، وكان الإعلام اليوناني في اتجاه الانسحاب من الأناضول[254]، بينما كانت الروح المعنويَّة مرتفعةً عند الأتراك، ومِنْ ثَمَّ قضوا شهورًا في إعداد جيشهم لحملةٍ فاصلةٍ تُنهي الوجود اليوناني في الأناضول. تسلَّمت الحركة الوطنية التركية معونةً عسكريَّة وماليَّة كبيرة من روسيا في مايو 1922م (ثلاثة ونصف مليون روبيَّة ذهبيَّة)[255]، وهذا ساعدهم في تحديد حملتهم الحاسمة.
في 26 أغسطس 1922 بدأت الحملة التي يُسمِّيها الأتراك: «الهجوم العظيم» Great Offensive[256]، وفي 27 أغسطس سقطت في أيديهم مدينة أَفْيُون Afyon، وبعدها بثلاثة أيام، في 30 أغسطس، حقَّق الجيش التركي نصرًا كبيرًا جدًّا في موقعة دوملوبينار Dumlupınar[257]، وهي قريبةٌ من كوتاهية. في هذه الموقعة فَقَد الجيش اليوناني نصفه بين قتيلٍ وأسير، مع تدميرٍ كاملٍ لسلاح الجيش أو أخذه كغنيمة[258]، وكان من بين الأسرى قائد الجيش اليوناني نيكولاس تريكوبيس Nikolaos Trikoupis[259]! يؤخذ هذا اليوم -30 أغسطس- عطلةً في تركيا الآن بعنوان يوم النصر Victory Day[260]. بعد الموقعة بيومين خاطب مصطفى كمال جيشه بجملته الشهيرة: «أيتها الجيوش! البحر المتوسط هدفكم. إلى الأمام»[261]! هذا يعني مطاردة اليونانيين إلى آخر نقطةٍ في الأناضول، وهو ما حدث بالفعل!
في 2 سبتمبر سقطت في أيدي الجيش التركي إسكيشيهير، وسارعت اليونان بالتوسُّل لبريطانيا للضغط على الحركة الوطنية لقبول هدنةٍ حربيَّةٍ لحفظ إزمير على الأقل[262]، ولكن الحركة رفضت، وأكملت طريقها لتحرير بقيَّة غرب الأناضول[263].
تحرَّكت الجيوش التركيَّة بسرعةٍ في أكثر من اتجاه في جبهاتٍ على اتِّساع أربعمائة كيلو متر، وفي 7 سبتمبر تمكنت من استرداد مدينة أيدن المهمَّة[264]، وفي 8 سبتمبر تحرَّرت مانيسا[265]، وفي اليوم التالي -9 سبتمبر- دخل جيش الحركة الوطنية إزمير فاتحًا[266][267]. كان يومًا كبيرًا. تحرَّرت المدينة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتلال. في 13 سبتمبر بورصا في يد الجيش التركي[268]، وبحلول يوم 15 سبتمبر 1922م كان اليونانيون قد خرجوا بالكامل من الأناضول[269].
كانت التداعيات كبيرة للغاية في اليونان! استقال رئيس الحكومة بتروس بروتوباباداكيس Petros Protopapadakis أثناء الهجوم التركي في أواخر أغسطس 1922[270]، وحدث انقلابٌ عسكريٌّ في 11 سبتمبر، وبعده -في 27 سبتمبر- اضطرَّ الملك كونستانتين الأول إلى التنازل عن العرش لابنه چورچ الثاني George II[271]! وفي 28 نوفمبر أُعدم رئيس الحكومة السابق بروتوباباداكيس وخمسة معه بتهمة التسبُّب في هزيمة اليونان[272]!
الحقُّ إنه لم يكن انتصارًا عاديًّا، خاصَّةً إذا نظرنا إلى ظروف الانقسام السياسي الذي تُعاني منه الدولة العثمانية (التركيَّة) آنذاك، وفي ظلِّ حكومةٍ ثنائيَّة (مصطفى كمال والسلطان محمد السادس)، وفي ظلِّ جيشٍ يحارب منذ سنواتٍ ثلاث في ثلاث جبهات (أرمينيا، وفرنسا، واليونان). يقول المؤرِّخ البولندي الأميركي چورچ لينكزوسكي George Lenczowski: «منذ بدأ الهجوم وهو مبهر! في خلال أسبوعين ساق الأتراك الجيشَ اليوناني إلى البحر المتوسط»[273]!
هدنة مودانيا (1922م):
منتشيًا بالنصر في الأناضول قرَّر مصطفى كمال استكمال مهمَّة تحرير «الوطن» كما جاء في الميثاق، وذلك عن طريق عبور المضايق لتحرير تراقيا الشرقية eastern Thrace التي يسيطر عليها اليونانيون منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، وذلك بغية الوصول إلى الحدود التركيَّة في الميثاق الوطني، وهي كما مرَّ بنا تصل إلى نهر ماريتزا Maritsa River. كانت إسطنبول -أيضًا- محتلَّةً من قوى الحلفاء الثلاثة، ولكن أرجأ مصطفى كمال التفكير في دخولها لحين الانتهاء من تراقيا الشرقية الأسهل، ومع ذلك فقد أرسل بعضًا من جنوده مستخفين إلى داخل إسطنبول لتمهيد الشعب هناك إلى احتمال الحرب داخل إسطنبول ذاتها[274].
كان انتقال مصطفى كمال إلى تراقيا الشرقية يعني التحرُّك بجيشه من خلال المضايق وشمال بحر إيجة، وحيث إن هذه منطقة دوليَّة محايدة منذ هدنة مودروس عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، فقد اعترض الجيش البريطاني في المنطقة، وجاء الردُّ من الحكومة البريطانيَّة في لندن في 23 سبتمبر 1922م برفض إعطاء تراقيا الشرقية للأتراك تنفيذًا لمعاهدة سيڤر التي أعطت تراقيا الشرقية لليونان، وعَرَضَت بريطانيا هدنةً على الحركة الوطنية لدراسة الأمر. رفض مصطفى كمال هذه الهدنة، وأعلن أن الحركة لا تقرُّ أصلًا بمعاهدة سيڤر، وحرَّك قوَّاته بالفعل في الأناضول لتصل إلى مضيق الدردنيل من الناحية الآسيويَّة في مقابل مدينة چنق Chanak المقابلة على الناحية الأوروبِّيَّة[275].
إزاء التحرُّكات التركيَّة قامت قوَّاتٌ عسكريَّةٌ من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالتقدُّم من إسطنبول نحو مدينة چنق غرب الدردنيل، وظهرت بوادر الحرب، في أزمةٍ أوروبِّيَّةٍ شهيرة عُرِفت بأزمة چنق Chanak Crisis[276]! دعا رئيس وزراء بريطانيا ديڤيد لويد چورچ إلى إعلان الحرب على الحركة الوطنية التركية، لكنَّه جوبه بمعارضةٍ كبيرةٍ في مجلس النوَّاب البريطاني[277]. لم تكن فرنسا وإيطاليا راغبتَيْن في الحرب؛ -غالبًا- نكاية في بريطانيا التي ستجني وحدها ثمار الفوز على الأتراك، ولذلك عند احتدام الموقف سحبت الدولتان جيوشهما من جنق تاركتَيْن بريطانيا وحدها في مواجهة جيش مصطفى كمال[278]. من ناحيةٍ أخرى، على المستوى الدبلوماسي، ضغطت فرنسا، وإيطاليا، ورومانيا، ويوغوسلاڤيا (تكوَّنت بعد الحرب عام 1918م باندماج صربيا، وكرواتيا، وسلوڤينيا) على بريطانيا لقبول الطلب التركي تجنُّبًا للحرب[279]، ومن جانبٍ آخر ضغطت فرنسا على مصطفى كمال لقبول الهدنة. وافق مصطفى كمال على إجراء مفاوضات الهدنة على أساس قبول عودة تراقيا الشرقية إلى تركيا[280]. بدأت المفاوضات في 3 أكتوبر 1922م في بلدة مودانيا التابعة لبورصا، وبحضور وفود بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان. كانت المفاوضات شاقَّةً للغاية، وقد مثَّل فيها الجانب التركي قائد المنطقة الغربية عصمت إينونو الذي أبدى دبلوماسيَّةً احترافيَّة.
من الجدير بالذكر أن فرنسا وإيطاليا وقفتا في المفاوضات إلى جوار الحركة الوطنية التركية على حساب بريطانيا واليونان[281]. في أثناء المفاوضات هدَّدت الحركة الوطنية باقتحام إسطنبول عسكريًّا إن لم تقبل بريطانيا بعودة تراقيا الشرقية إلى تركيا. إزاء صلابة الحركة الوطنية في المفاوضات وافقت الحكومة البريطانيَّة على إعادة تراقيا الشرقية لتركيا، ومِنْ ثَمَّ عُقِدت هدنةٌ بين الحركة الوطنية من جهة، وبين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من جهةٍ أخرى، وذلك في يوم 11 أكتوبر 1922[282][283]. رفضت اليونان في البداية التوقيع على المعاهدة، ولكنها -وتحت الضغط الإنجليزي- وافقت في النهاية، وقامت بالتوقيع عليها في 14 أكتوبر 1922م[284]، وكانت الهدنة تقضي بإخلاء اليونانيين لتراقيا الشرقية في خلال خمسة عشر يومًا من التوقيع، وتسليمها لقوَّةٍ مدنيَّةٍ من الحركة الوطنية[285][286]، إلى أن تعقد اتفاقات سلامٍ مفصَّلةٍ بعد ذلك؛ إذ إن إسطنبول ما زالت تحت سيطرة القوى الأوروبِّيَّة.
الحقُّ كان نصرًا كبيرًا للحركة الوطنية التركية!
هكذا تحرَّر الأناضول وتراقيا الشرقية، ووصلت الحركة الوطنية «بالقوَّة» إلى الحدود التي أعلنتها في الميثاق الوطني قبل ذلك بثلاث سنوات، باستثناء إسطنبول التي تحتاج جهدًا آخر[287].
[1] كولن، صالح: سلاطين الدولة العثمانية، ترجمة: منى جمال الدين، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1435هـ=2014م.صفحة 342.
[2] لويس، برنارد: ظهور تركيا الحديثة، ترجمة: قاسم عبده قاسم، سامية محمد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2016م. الصفحات 277، 278.
[3] دريفوس، رولان ماركس؛ وجورج، فرنسوا؛ وبوادوفان، ريمون: موسوعة تاريخ أوروبا العام (أوروبا من عام 1789 حتى أيامنا)، مراجعة: أنطوان أ. الهاشم، ترجمة: حسين حيدر، منشورات عويدات، بيروت–باريس، الطبعة الأولى، 1995م.صفحة 3/368.
[4] Thomas, 2012, pp. 11-12.
[5] تايلور، 2009 صفحة 750.
[6] Churchill, Winston S.: The World Crisis, 1911-1918, Thornton Butterworth, Limited, London, UK, 1932., p. 546.
[7] Edmonds, Sir James. E.: Military Operations: France and Belgium, 1918, Volume 3: May–July: The German Diversion Offensives and the First Allied Counter-Offensive. History of the Great War Based on Official Documents By Direction of the Historical Section of the Committee of Imperial Defence, Macmillan, London, UK, 1939., vol. 3, p. 306.
[8] Murphy, David: The French Army in 1918, In: Strohn, Matthias: 1918: Winning the War, Losing the War, Bloomsbury Publishing, Oxford, UK, 2018., p. 87.
[9] Thomas, 2012, p. 12.
[10] Churchill, 1932, p. 546.
[11] فشر، 1972 صفحة 535.
[12] Guinan, Paul & Bennett, Anina: Boilerplate: History's Mechanical Marvel, Abrams, New York, USA, 2009., p. 116.
[13] Simkins, Peter: Co-Stars or Supporting Cast? British Divisions in the «Hundred Days» 1918, In: Griffith, Paddy: British Fighting Methods in the Great War, Frank Cass Publishers, London, UK, 1996., pp. 50-69.
[14] Harris, Paul: The Franco-British Military Alliance during World War I, In: Mansoor, Peter R. & Murray, Williamson: Grand Strategy and Military Alliances, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2016, p. 133.
[15] فشر، هربرت. أ. ل.: تاريخ أوروبا في العصر الحديث (1789-1950)، ترجمة: أحمد نجيب هاشم، وديع الضبع، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، 1972م. الصفحات 536، 537.
[16] قاسم، محمد؛ وحسني، حسين: تاريخ القرن التاسع عشر في أوروبا منذ عهد الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العظمى، مطبعة دار الكتب المصرية-لجنة التأليف والنشر، القاهرة، الطبعة السادسة، 1348هـ=1929م.صفحة 287.
[17] فرومكين، ديفيد: نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط، قراءة وتقديم: منذر الحايك، ترجمة: وسيم حسن عبدو، دار صفحات للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 2015م.صفحة 297.
[18] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، 1990 صفحة 2/246.
[19] بوزرسلان، حميد: تاريخ تركيا المعاصر، ترجمة: حسين عمر، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث-أبو ظبي، المركز الثقافي العربي-بيروت، الطبعة الأولى، 1430هـ=2009، صفحة 33.
[20] بكديللي، كمال: الدولة العثمانية من معاهدة قينارجه الصغرى حتى الانهيار، ضمن كتاب: إحسان أوغلي، أكمل الدين: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة: صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 1999م. صفحة 1/139.
[21] دومون، ﭘول؛ وﭼورﭼو، فرانسوا: موت إمبراطورية (1908 - 1923)، ضمن كتاب: مانتران، روبير: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: بشير السباعي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة–باريس، الطبعة الأولى، 1993م. صفحة 2/331.
[22] لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة: عفيفة البستاني، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الثامنة، 1985م. صفحة 473.
[23] مانجو، أندرو: أتاتورك (السيرة الذاتية لمؤسس تركيا الحديثة)، ترجمة: عمر سعيد الأيوبي، دائرة الثقافة والسياحة، مشروع كلمة، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 2018م. صفحة 208.
[24] كولن، 2014 صفحة 343.
[25] مانسيل، فيليب: القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924، ترجمة: مصطفى محمد قاسم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1436هـ=2015م.صفحة 2/217.
[26] Beckett, Ian Frederick William: The Great War, 1914-1918, Second Edition, Routledge, London, UK, 2007., p. 545.
[27] دريفوس، رولان ماركس؛ وجورج، فرنسوا؛ وبوادوفان، ريمون: موسوعة تاريخ أوروبا العام (أوروبا من عام 1789 حتى أيامنا)، مراجعة: أنطوان أ. الهاشم، ترجمة: حسين حيدر، منشورات عويدات، بيروت–باريس، الطبعة الأولى، 1995م.صفحة 3/369.
[28] مانسيل، 2015 صفحة 2/217.
[29] أحمد، كمال مظهر: كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ترجمة: محمد الملا عبد الكريم، دار أراس للطباعة والنشر، أربيل–العراق، الطبعة الثالثة، 2013م.صفحة 332.
[30] فرومكين، ديفيد: سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسط 1914 – 1922، ترجمة: أسعد كامل الياس، شركة رياض الريس للكتب والنشر، لندن، الطبعة الأولى، 1992م. الصفحات 414، 416.
[31] McMeekin, Sean: The Ottoman Endgame: War, Revolution, and the Making of the Modern Middle East, 1908-1923, Penguin Books, New York, USA, 2015., p. 409.
[32] مانجو، 2018 صفحة 209.
[33] دومون، وﭼورﭼو، 1993 صفحة 2/331.
[34] مانجو، 2018 الصفحات 209، 210.
[35] Macfie, Alexander Lyon: The End of the Ottoman Empire, 1908-1923, Routledge, New York, USA, 2013 (A).pp. 173-174.
[36] دومون، وﭼورﭼو، 1993 الصفحات 2/331، 332.
[37] McMeekin, 2015, p. 409.
[38] Busch, Briton Cooper: Mudros to Lausanne: Britain's Frontier in West Asia, 1918-1923, State University of New York Press, Albany, New York, USA, 1976., p. 10.
[39] دومون، وﭼورﭼو، 1993 صفحة 2/332.
[40] مانجو، 2018 صفحة 210.
[41] بكديللي، 1999 صفحة 1/140.
[42] كولن، 2014 صفحة 343.
[43] مانجو، 2018 صفحة 216.
[44] Criss, Nur Bilge: Istanbul Under Allied Occupation, 1918-1923, Brill, Leiden, Netherlands, 1999., p. 60.
[45] Stewart, William: Admirals of the World: A Biographical Dictionary, 1500 to the Present, McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, USA, 2009., p. 146.
[46] Knight, Paul: The British Army in Mesopotamia, 1914-1918, McFarland & Company. Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, USA, 2013., pp. 153.
[47] أولريخسن، كريستيان كوتس: الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط، ترجمة: طارق عليان، جروس برس ناشرون، طرابلس-لبنان، الطبعة الأولى، 2016م. الصفحات 235–238، 275–277.
[48] Sicker, Martin: The Middle East in the Twentieth Century, Greenwood Publishing Group, Westport, CT, USA, 2001 (B).p. 83.
[49] روبنس، فيليب: تركيا والشرق الأوسط، ترجمة: ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث، قبرص، الطبعة الأولى، 1993م. صفحة 30.
[50] مانجو، 2018 صفحة 211.
[51] بوزرسلان، 2009 صفحة 43.
[52] روبنس، 1993 صفحة 30.
[53] شانيولو، جان بول؛ وسياح، سيدي أحمد: مسألة الحدود في الشرق الأوسط، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، الطبعة الأولى، 2006م.صفحة 160.
[54] Gawrych, George W.: The Young Atatürk: From Ottoman Soldier to Statesman of Turkey, I.B.Tauris, London, UK, 2013., p. 95.
[55] مانجو، 2018 صفحة 213.
[56] لويس، 2016 صفحة 296.
[57] Gawrych, 2013, p. 95.
[58] فشر، 1972 صفحة 580.
[59] أولريخسن، 2016 صفحة 280.
[60] فشر، 1972 صفحة 551.
[61] روجان، يوجين: العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2011م.صفحة 196.
[62] Meehan, John David: The Dominion and the Rising Sun: Canada Encounters Japan, 1929-41, UBC Press, Vancouver, Toronto, Canada, 2004, pp. 76-77.
[63] Crozier, Andrew J.: The Establishment of the Mandates System 1919–25: Some Problems Created by the Paris Peace Conference, Journal of Contemporary History, SAGE Publishing, Thousand Oaks, California, USA, Volume 14, Issue 3, 1979., pp. 483–513.
[64] مكارثي، جستن: الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين (1821 - 1922م)، ترجمة: فريد الغزي، دار قدمس للنشر والتوزيع، (دون سنة طبع). الصفحات 264-267.
[65] Jensen, Peter Kincaid: The Greco-Turkish War, 1920–1922, International Journal of Middle East Studies, Middle East Studies Association of North America, Cambridge University Press, USA, Volume 10, Issue 4, 1979., pp. 553–565.
[66] لويس، 2016 الصفحات 297، 298.
[67] مانجو، 2018 صفحة 236.
[68] Kalaycıoğlu, Ersin: Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands, Palgrave Macmillan, New York, USA, 2005., p. 37.
[69] Akşin, Sina: Turkey, from Empire to Revolutionary Republic: The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to Present, Translated from the Turkish: Dexter H. Mursaloğlu, New York University Press, New York, USA, 2007, p. 125.
[70] Stavridis, Stavros T.: The Greek-Turkish War, 1918-23: An Australian press perspective, Gorgias Press, Piscataway, New Jersey, USA, 2008., p. 117.
[71] Akşin, 2007, p. 125.
[72] Bulutgil, H. Zeynep: The Roots of Ethnic Cleansing in Europe, Cambridge University Press, New York, USA, 2016., pp. 117-118.
[73] مكارثي، (دون سنة طبع) الصفحات 273–285.
[74] مانجو، 2018 الصفحات 229، 230.
[75] Akşin, 2007, p. 127.
[76] مانسيل، 2015 صفحة 2/232.
[77] مانجو، 2018 صفحة 226.
[78] شانيولو، وسياح، 2006 الصفحات 64، 65.
[79] فشر، 1972 صفحة 580.
[80] لويس، 2016 صفحة 300.
[81] Wiest, Andrew: World War I, Cavendish Square Publishing, LLC, New York, USA, 2017., p. 97.
[82] مانجو، 2018 صفحة 233.
[83] لويس، 2016 صفحة 302.
[84] آق كوندز، أحمد؛ وأوزتورك، سعيد: الدولة العثمانية المجهولة، وقف البحوث العثمانية، إسطنبول، 2008م.صفحة 480.
[85] دروزه، محمد عزة: تركيا الحديثة، مطبعة الكشاف، بيروت، 1365هـ=1946م. صفحة 15.
[86] لويس، 2016 الصفحات 298، 302.
[87] مانجو، 2018 صفحة 239.
[88] Volkan, Vamik D. & Itzkowitz, Norman: Immortal Ataturk: A Psychobiography, University of Chicago Press, Chicago, USA, 1984., p. 9.
[89] دومون، وﭼورﭼو، 1993 صفحة 2/338.
[90] Hale, William: Turkish Politics and the Military, Routledge, New York, USA, 1994., p. 69.
[91] Dural, A. Baran: His Story: Mustafa Kemal and Turkish Revolution, iUniverse, Bloomington, Indianapolis, USA, 2007., p. 40.
[92] مانجو، 2018 صفحة 244.
[93] Dural, 2007, pp. 51-52.
[94] لويس، 2016 صفحة 303.
[95] مانجو، 2018 الصفحات 253، 254.
[96] بكديللي، 1999 صفحة 1/141.
[97] دروزه، 1946 صفحة 20.
[98]. Zürcher, Erik Jan: Turkey: A Modern History, I.B. Tauris & Co Ltd, London, UK, 2004.
p. 150.
[99] دومون، وﭼورﭼو، 1993 صفحة 2/339.
[100] Mango, 2013, p. 9.
[101] Hale, 1994, p. 61.
[102] بوزرسلان، 2009 صفحة 39.
[103] دروزه، 1946 صفحة 26.
[104] Akşin, 2007, p. 146.
[105] Davison, Roderic H.: Turkish Diplomacy from Mudros to Lausanne, In: Craig, Gordon A. & Gilbert, Felix: The Diplomats, 1919-1939, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 1994., p. 180.
[106] Shaw, Stanford Jay: From Empire to Republic: The Turkish War of National Liberation, 1918-1923: a Documentary Study, Turkish Historical Society, 2000., pp. 655-656.
[107] لويس، 2016 صفحة 305.
[108] Macfie, Alexander Lyon: Atatürk, Routledge, New York, USA, 2013 (B)., p. 88.
[109] بكديللي، 1999 صفحة 1/141.
[110] Hale, 2013, p. 33.
[111] Macfie, 2013 (B), p. 88.
[112] لويس، 2016 صفحة 306.
[113] كولن، 2014 صفحة 348.
[114] Hovannisian, Richard G.: The Republic of Armenia, Volume 3: From London to Sèvres, February-August 1920, University of California Press, Berkeley, California, USA, 1996., vol. 3, pp. 41-42.
[115] 4. Atatürk, Mustafa Kemal: Atatürk'ün bütün eserleri [The Complete Works of Atatürk] (In Turkish), Kaynak Yayınları, Istanbul, Turkey, 1998, vol. 17, p. 219.
[116] Hovannisian, Richard G.: The Postwar Contest for Cilicia and the «Marash Affair»، In: Hovannisian, Richard G. & Payaslian, Simon: Armenian Cilicia, Mazda Publishers, Costa Mesa, California, USA, 2008., pp. 510-511.
[117] مانسيل، 2015 صفحة 2/233.
[118] Turnaoğlu, Banu: The Formation of Turkish Republicanism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2017., p. 205.
[119] Dunn, John P.: Sèvres, Treaty of (August 10,1920), In: Tucker, Spencer C.: The European Powers in the First World War: An Encyclopedia, Routledge, New York, USA, 2013., p. 639.
[120] دروزه، 1946 صفحة 29.
[121] McMeekin, 2012, p. 41.
[122] لويس، 2016 صفحة 306.
[123] دروزه، 1946 صفحة 30.
[124] Jenkins, 2008, p. 85.
[125] واحدة، شكران: الاسلام في تركيا الحديثة: بديع الزمان النورسي، المراجعة: إحسان قاسم الصالحي، ترجمة: محمد فاضل، 2007م. صفحة 221.
[126] Jenkins, 2008, p. 85.
[127] Nafziger, George F. & Walton, Mark W.: Islam at War: A History, Praeger Publishers, Westport, Connecticut, USA, 2003, p. 181.
[128] لويس، 2016 صفحة 307.
[129] واحدة، 2007 صفحة 221.
[130] Tachjian, Vahé: The Cilician Armenians and French Policy, 1919-1921, In: Hovannisian, Richard G. & Payaslian, Simon: Armenian Cilicia, Mazda Publishers, Costa Mesa, California, USA, 2008., p. 550.
[131] Davison, Roderic H.: Turkish Diplomacy from Mudros to Lausanne, In: Craig, Gordon A. & Gilbert, Felix: The Diplomats, 1919-1939, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 1994., p. 181.
[132] Kalaycıoğlu, Ersin: The Turkish Grand National Assembly: New Challenges and Old Problems, In: Kerslake, Celia; Öktem, Kerem & Robins, Philip: Turkey’s Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, Palgrave Macmillan, New York, USA, 2010., p. 122.
[133] بكديللي، 1999 صفحة 1/142.
[134] بروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة: نبيه أمين فارس، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 1968م.صفحة 690.
[135] دروزه، 1946 صفحة 31.
[136] Ahmad, Feroz: The Making of Modern Turkey, Routledge, London, UK, 1993., p. 50.
[137] مانجو، 2018 صفحة 295.
[138] Okyar, Osman: Atatürk's Quest for Modernism, In: Landau, Jacob M.: Atatürk and the Modernization of Turkey, BRILL, Leiden, Netherlands, 1984., p. 49.
[139] Srinivasan, Ramona: The Concept of Diarchy: In Special Reference to Its Working in the Bombay Presidency, 1921-1937, NIB Publishers, 1992., p. 24.
[140] Feldman, Ofer: Prime Minister's Wife, Minister's Disease, and Mummy Government: How Culture Affects Metaphors Used in Japanese Political Discourse, In: Magioglou, Thalia: Culture and Political Psychology: A Societal Perspective, Information Age Publishing, Charlotte, North Carolina, USA, 2014., p. 155.
[141] مانجو، 2018 الصفحات 296، 297.
[142] Tachjian, 2008, p. 550.
[143] Brecher, Michael & Wilkenfeld, Jonathan: A Study of Crisis, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, USA, 1997., p. 363.
[144] Howard, Douglas Arthur: The History of Turkey, ABC-CLIO, LLC, Californai, USA, Second Edition, 2016., p. 89.
[145] Firat, Melek: Relations with Greece, In: Oran, Baskın: Turkish Foreign Policy, 1919-2006: Facts and Analyses with Documents, Translated: Mustafa Akşin, University of Utah Press, Salt Lake City, Utah, USA, 2010., p. 107.
[146] مانجو، 2018 صفحة 295.
[147] Kirişci, Kemal & Winrow, Gareth M.: The Kurdish Question and Turkey: An Example of a Trans-state Ethnic Conflict, Routledge, New York, USA, 2013., p. 74.
[148] Saparov, 2015, p. 71.
[149] Gokay, Bulent: Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism, Routledge, 2006., p. 15.
[150] بكديللي، 1999 صفحة 1/142.
[151] لويس، 2016 صفحة 308.
[152] سولت، جيرمي: تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، ترجمة: نبيل صبحي الطويل، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 1432هـ=2011م.صفحة 95.
[153] Helmreich, Paul C.: From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919–1920, Ohio State University Press, Columbus, Ohio, USA, 1974., p. 320.
[154] Lee, Seokwoo: Territorial Settlements in Peace Treaties, In: Hébié, Mamadou & Kohen, Marcelo G.: Research Handbook on Territorial Disputes in International Law, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA, 2018., p. 273.
[155] بروكلمان، 1968 صفحة 691.
[156] Oran, Baskın: The Peace Treaty of Sèvres, In: Oran, Baskın: Turkish Foreign Policy, 1919-2006: Facts and Analyses with Documents, Translated: Mustafa Akşin, University of Utah Press, Salt Lake City, Utah, USA, 2010., p. 69.
[157] Howard, 1947, p. 19.
[158] قاسم، وحسني، 1929 صفحة 292.
[159] Martin, 2007 (B), vol. 1, p. 918.
[160] Somel, Selçuk Akşin: Historical Dictionary of the Ottoman Empire, Lanham, Maryland, USA, Scarecrow Press, 2003., p. 309.
[161] Verzijl, J. H. W.: International Law in Historical Perspective, A. W.Sijthoff, Leyden, Netherlands, 1970., vol. 3, pp. 508-509.
[162] قاسم، وحسني، 1929 صفحة 292.
[163] Waibel, Michael: Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v Great Britain) (1924–27), In: Bjorge, Eirik & Miles, Cameron: Landmark Cases in Public International Law, Bloomsbury Publishing, London, UK, 2017., p. 34.
[164] Friedman, 1992, p. 309.
[165] قاسم، وحسني، 1929 صفحة 292.
[166] Somel, 2003, p. 309.
[167] Martin, 2007 (B), vol. 1, p. xxxvii-xxxviii.
[168] De Waal, 2010, p. 68.
[169] شانيولو، وسياح، 2006 صفحة 58.
[170] فرومكين، 2015 صفحة 322.
[171] دروزه، 1946 صفحة 39.
[172] Metz, Helen Chapin: Iraq: A Country Study, In: Jeffries, Leon M.: Iraq: Issues, Historical Background, Bibliography, Nova Science Publishers, New York, USA, 2003., p. 146.
[173] Benoist-Méchin, Jaques: Turkey 1908-1938: The End of the Ottoman Empire: A History in Documentary Photographs, Swan Productions AG, Zug, Switzerland, 1989., 1989, p. 166.
[174] دروزه، 1946 صفحة 38.
[175] سولت، 2011 صفحة 95.
[176] Lee, 2018, p. 273.
[177] قاسم، وحسني، 1929 صفحة 292.
[178] Chatty, Dawn: Displacement and Dispossession in the Modern Middle East, Cambridge University Press, New York, USA, 2010., p. 161.
[179] دروزه، 1946 صفحة 39.
[180] سولت، 2011 صفحة 95.
[181] Bulutgil, H. Zeynep: The Roots of Ethnic Cleansing in Europe, Cambridge University Press, New York, USA, 2016., p. 117.
[182] Vezenkov, Alexander: Entangled Geographies of the Balkans: The Boundaries of the Region and the Limits of the Discipline, In: Daskalov, Roumen Dontchev; Mishkova, Diana; Marinov, Tchavdar & Vezenkov, Alexander: Entangled Histories of the Balkans, Volume Four: Concepts, Approaches, and Self-Representations, Brill, Leiden, Netherlands, 2017., vol. 4, p. 159.
[183] دروزه، 1946 صفحة 39.
[184] Martin, Lawrence: The Treaties of Peace, 1919-1923, The Lawbook Exchange, LTD, Clark, New Jersey, USA, 2007 (B).vol. 1, p. 869.
[185] Hüseyin Al: Debt and the Public Debt Administration, In: Ágoston, Gábor & Masters, Bruce Alan: Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, New York, USA, 2009, pp. 181-182.
[186] مانسيل، 2015 صفحة 2/237.
[187] بكديللي، 1999 صفحة 1/136.
[188] Somel, 2003, p. 309.
[189] Martin, 2007 (B), vol. 1, p. 916.
[190] دروزه، 1946 صفحة 39.
[191] Martin, 2007 (B), vol. 1, p. 895.
[192] Somel, 2003, p. 309.
[193] دروزه، 1946 صفحة 40.
[194] Hosono, Gunji: International Disarmament, Sociét ́ d'Imprimerie d'Ambilly-Annemasse, Auvergne-Rhône-Alpes, France, 1926., p. 143.
[195] Martin, 2007 (B), vol. 1, pp. 847-848.
[196] McNabb, David E.: Oil and the Creation of Iraq: Policy Failures and the 1914-1918 War in Mesopotamia, Routledge, New York, USA, 2016., p. 132.
[197] دروزه، 1946 صفحة 39.
[198] Somel, 2003, p. 309.
[199] دروزه، 1946 صفحة 39.
[200] Somel, 2003, p. 309.
[201] Dunn, 2013, p. 639.
[202] Wagner, Heather Lehr: The Division of the Middle East: The Treaty of Sèvres, Chelsea House Publishers, Philadelphia, USA, 2004., p. 91.
[203] Lenczowski, 1960, p. 15.
[204] Kia, Mehrdad: The Ottoman Empire: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2017., vol. 2, p. 48.
[205] Rao, B. V.: History of Asia: From Early Times to the Present, New Dawn Press, New Delhi, India, 2005., p. 420.
[206] دروزه، 1946 الصفحات 37، 38.
[207] لويس، 2016 صفحة 302.
[208] سولت، 2011 الصفحات 65، 97.
[209] Mandelbaum, Michael: The Fate of Nations: The Search for National Security in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge University Press, 1988., p. 61.
[210] Friedman, Isaiah: British Miscalculations: The Rise of Muslim Nationalism, 1918–1925, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, USA, 2012., p. 217.
[211] بكديللي، 1999 صفحة 1/142.
[212] مانجو، 2018 صفحة 302.
[213] Akçam, Taner: From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, Zed Books, New York, USA, 2004., p. 180.
[214] Özoğlu, Hakan: From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2011., p. 47.
[215] مكارثي، (دون سنة طبع) صفحة 260.
[216] McMeekin, 2012, p. 41.
[217] Şimşir, Bilâl N.: Ermeni Meselesi, 1774–2005 (The Armenian Question, 1774–2005) (In Turkish), Bilgi Yayınevi, Ankara, Turkey, 2005., p. 182.
[218] Hovannisian, 1996, vol. 3, pp. 182-190.
[219] دروزه، 1946 صفحة 41.
[220] مكارثي، (دون سنة طبع) صفحة 196.
[221] مانجو، 2018 الصفحات 309، 310.
[222] شانيولو، وسياح، 2006 الصفحات 59، 60.
[223] Hille, 2010, p. 154.
[224] بكديللي، 1999 صفحة 1/142.
[225] أولريخسن، 2016 صفحة 288.
[226] Thomas, Martin & Toye, Richard: Arguing about Empire: Imperial Rhetoric in Britain and France, 1882-1956, Oxford University Press, Oxford, UK, 2019., 2019, p. 132.
[227] Zürcher, 2004, p. 154.
[228] Pentzopoulos, Dimitri: The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact on Greece, C. Hurst & Co. Publishers, London, UK, 2002., pp. 43-44.
[229] Gokay, Bulent: Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism, Routledge, 2006, p. 29.
[230] Boinodiris, Stavros: Andros Odyssey: Liberation: (1900-1940), iUniverse, 2010., p. 121.
[231] مانجو، 2018 صفحة 338.
[232] Heper, Metin: İsmet İnönü: The Making of a Turkish Statesman, BRILL, 1998, p. 66.
[233] Lentz, Harris M.: Heads of States and Governments Since 1945, Routledge, 2014., p. 763.
[234] مانجو، 2018 الصفحات 338، 341.
[235] Palmer, Alan Warwick: Who's who in Modern History: From 1860 to the Present Day, Psychology Press, 2002., p.174.
[236] بوزرسلان، 2009 الصفحات 157، 158.
[237] مانجو، 2018 الصفحات 345، 346.
[238] Sonyel, Salâhi Ramadan: Atatürk: The Founder of Modern Turkey, Turkish Historical Society, Print House, Ankara, Turkey, 1989., p. 78.
[239] Smith, Michael Llewellyn: Ionian Vision – Greece in Asia Minor 1919–1922, Hurst & Company, London, First published, 1973., p. 233.
[240] مانجو، 2018 صفحة 348.
[241] McMeekin, 2012, p. 42.
[242] Kinzer, Stephen: Reset: Iran, Turkey, and America's Future, Henry Holt and Company, LLC, New York, USA, 2010., p. 51.
[243] فشر، 1972 صفحة 582.
[244] مانجو، 2018 الصفحات 351، 352.
[245] Smith, 1973, p. 234.
[246] مكارثي، (دون سنة طبع) صفحة 291.
[247] Shaw, Stanford Jay & Shaw, Ezel Kural: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Volume II, Cambridge University Press, New York, USA, 1977., vol. 2, p. 361.
[248] McMeekin, 2012, p. 42.
[249] مانجو، 2018 صفحة 341.
[250] دروزه، 1946 صفحة 51.
[251] Somel, 2010, p. lxviii.
[252] بروكلمان، 1968 صفحة 692.
[253] دروزه، 1946 صفحة 51.
[254] Yapp, Malcolm E.: The Making of the Modern Near East, 1792–1923, Longman, New York, USA, 1987., p. 319.
[255] Gokay, Bulent: Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism, Routledge, 2006, p. 29.
[256] واحدة، 2007 صفحة 259.
[257] مانجو، 2018 الصفحات 370-372.
[258] Shaw & Shaw, 1977, vol. 2, p. 362.
[259] Kinross, Patrick Balfour Baron: Atatürk: The Rebirth of a Nation, Weidenfeld & Nicolson, London, UK, 1960., p. 315.
[260] Yilmaz, Hale: Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey 1923-1945, Syracuse University Press, Syracuse, New York, USA, 2013., p. 182.
[261] مانجو، 2018 صفحة 371.
[262] Shaw & Shaw, 1977, vol. 2, p. 363.
[263] دروزه، 1946 الصفحات 53، 54.
[264] Jowett, Philip S.: Armies of the Greek-Turkish War 1919–22, Osprey Publishing, Oxford, UK, 2015., p. 10.
[265] Dural, 2007, p. 96.
[266] دومون، وﭼورﭼو، 1993 صفحة 2/345.
[267] بوزرسلان، 2009 صفحة 40.
[268] Kalaycıoğlu, 2005, p. 39.
[269] Brecher & Wilkenfeld, 1997, p. 628.
[270] Kaika, Maria: City of Flows: Modernity, Nature, and the City, Routledge, New York, USA, 2005., p. 122.
[271] Der Kiste, John Van: Kings of the Hellenes: The Greek Kings 1863-1974, Sutton Publishing, Stroud, Gloucestershire, UK, 1994., p. 137.
[272] Lentz, Harris M.: Assassinations and Executions: An Encyclopedia of Political Violence, 1865-1986, McFarland, California, USA, 1988., p. 48.
[273] Lenczowski, George: The Middle East in World Affairs, Cornell University Press, Ithaca, New York, USA, 1962., p. 107.
[274] Hemingway, Ernest: Hemingway on War, Scribner, New York, USA, 2003., p. 278.
[275] Brecher &Wilkenfeld, 1997, p. 628.
[276] Shaw & Shaw, 1977, vol. 2, p. 363.
[277] Taylor, A. J. P.: English History 1914–1945, Oxford University Press, Oxford, UK, 1965., pp. 190–192.
[278] Hale, 2013, p. 38.
[279] Psomiades, Harry J.: The Eastern question: the last phase: A Study in Greek-Turkish diplomacy, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, Greek, 1968., p. 36.
[280] دروزه، 1946 الصفحات 54، 55.
[281] Psomiades, Harry J.: The Eastern question: the last phase: A Study in Greek-Turkish diplomacy, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, Greek, 1968., p. 36.
[282] مانجو، 2018 صفحة 382.
[283] كولن، 2014 صفحة 350.
[284] لويس، 2016 صفحة 309.
[285] دروزه، 1946 صفحة 55.
[286] مانجو، 2018 صفحة 383.
[287] انظر: دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442هـ= 2021م، 2/ 1228- 1273.








![نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12] نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12]](https://islamstory.com/images/upload/content_thumbs/1913613138ragheb-al-serjany-videos.jpg)
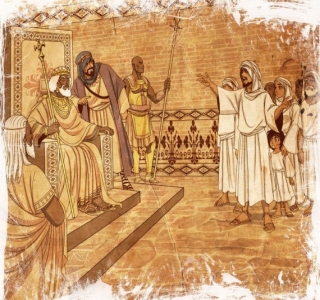

التعليقات
إرسال تعليقك